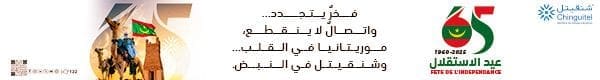ياسين عبد القادر الزوي
باحث في الشؤون الإفريقية
انتهت قبل أيام الجولة الثانية من حملة الانتخابات التشريعية في تونس، وهي أخر المحطات في خارطة طريق ما بعد 25 يوليو 2021، التي يعتبرها البعض انقلابا على الدستور، بينما يراها آخرون تصحيحاً للمسار الديمقراطي.
ولقد سبقت هذه الانتخابات التشريعية الأخيرة، جولة أولى نفذت في شهر ديسمبر الماضي، وقبلها تم تنظيم استفتاء على الدستور، وأيضا الاستشارة الإلكترونية!
ورغم المشاركة المتدنية جداً في جولتي الانتخابات التشريعية، نسبة 11%، إلا أن بعض المراقبين سجلوا للسلطات التونسية عدم اللجوء للتزوير والتدليس مع أنه كان بمقدورها القيام به لو أرادت ذلك!
كما يُعدُّ لصالح السلطات التونسية نجاحها في تنظيم هذه المحطات الانتخابية الواحدة تلو الأخرى، ولم تسفك قطرة دم واحدة.
أما اللغط المثار حول تدني نسبة المشاركة، فهو أمرٌ اعتيادي بعد كل استحقاق انتخابي، حيث يفسره البعض كنتيجة حتمية للمقاطعة من قبل الأحزاب التونسية الوازنة، وذلك اعتراضا على القانون الانتخابي. بينما يرجعه البعض لظاهرة عزوف التونسيين عن الحياة السياسية، بسبب الإحباط الشديد من الوضع الاقتصادي العام، وتزايد وتيرة تكلفة المعيشة في تونس منذ سنوات!
كما قد يكون تدني نسبة المشاركة، سببه عدم وضوح الرؤية!
ومما لاشك فيه أن القانون الانتخابي الذي جرت بمقتضاه الانتخابات التشريعية كان صعبا ومغلقا ومعقدا، بمعنى أنه فرض قيودا شديدة على المرشحين مثل: أن يجري الاقتراع على الأفراد وليس على الأحزاب، وكذلك من يفوز بالمقعد البرلماني يحظر عليه العمل في قطاع أخر، ومنع إمكانية تغيير الانتماء السياسي أو ما يعرف في بعض الدول بالسياحة الحزبية (الترحال السياسي)، وأيضا سحب الوكالة بمعني أن يقوم ناخبو الدائرة بسحب وكالة هذا النائب إذا ما ترك الدائرة أو لم يقم بواجبه الانتخابي.
ومن المؤكد إن هذه النقاط وغيرها، دفعت الكثير من الأحزاب والقوى السياسية ورجال الأعمال، إلى عدم المغامرة بالترشح لهذا البرلمان ذي الصلاحيات المحدودة، في ظل تركز معظم السلطة في يد الرئيس.
إن اكتمال هذه الاستحقاقات المختلفة، وعودة الحياة البرلمانية، وإمكانية تشكيل حكومة جديدة من واقع الخريطة البرلمانية المنتخبة، كل ذلك سوف يخفف بعض الضغوط على الرئيس التونسي الذي نجح بشكل ما في الوفاء بتعهداته، من ناحية الالتزام بالمواعيد المقررة من دون تلكؤ، والالتزام بخارطة الطريق ما بعد 25 يوليو.
ومما لا شك فيه أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح من قبل المتابعين والمراقبين للوضع التونسي، حول مستقبل العملية السياسية في هذا البلد المغاربي.
والسؤال الأكثر أهمية هو طريقة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة التونسية؟
يوجد هناك شبه إجماع في تونس والمنطقة، على أن الرجل قفزت به الأقدار لقيادة تونس في ظل حالة عجز حزبية واضحة، وتضارب أجندة الأحزاب السياسية التونسية، حيث رأت حركة النهضة وهي الحزب الأكبر وبعض الأحزاب أن هذا الرجل يمكن أن يكون الشخص الذي يستطيع دغدغة مشاعر الشارع التونسي، بما يمتلكه من رصيد شخصي محترم بعيدا عن أية تجاذبات سياسية، في حين توقعت الأحزاب السياسية التونسية أن تكون بيدها السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان؛ وذلك في ضوء إجادتها للعبة البرلمانية طيلة عشر سنوات مضت!
وتعاطف كثير من التونسيين مع المرشح الرئاسي الذي يدير حملته الانتخابية من شقة صغيرة، مع كثير من المتطوعين العاديين، وهكذا حصل الرجل على فوز مقنع، مع تأييد شعبي كبير جدا، وهذه أشياء لا يمكن لأي طرف التشكيك فيها أو إنكارها.
إنني أعتبر نفسي من المهتمين بتونس البلد الشقيق والجار، وأحترم كثيرا تجربتها الديمقراطية الوليدة.
كما سبقت لي الكتابة عن تونس بمقالين؛ أحدهما صبيحة 25 يوليو، والثاني بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وكنت ومتابعين كثر للشأن التونسي، نتعجب من قدرة هذا الرجل على اتخاذ هذه القرارات الصعبة والكبيرة، وكيف يواجه بمفرده حزبا مؤدلجا مثل حركة النهضة (المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين)، وغيرها من أحزاب وتيارات سياسية.
مما لا شك فيه أن هناك ظروفا كثيرة ساعدت الرئيس قيس سعيد في تحجيم هذه الأحزاب، والظهور بمظهر الرجل القوي الحاسم، والمدعوم بمزاج شعبي عام عبر عن غضبه من أداء البرلمان والحكومات المتعاقبة في تونس، طيلة عشر سنوات سلفت.
وتعيش تونس – حاليا- ظروفا اقتصادية ضاغطة جدا وغير مسبوقة، تركت آثارها على كل مناحي الحياة. وهذه الأوضاع جعلت الرئيس قيس سعيد وحكومته التي جاءت بوعود كبيرة لجهة الإصلاح وتحسين الأوضاع، في مواجهة حقيقية مع فئات الشعب المختلفة، حيث تعاني الأغلبية من فقد المواد التموينية مع انهيار قدرة التونسيين الشرائية أمام تفاقم التضخم، وأثبتت الحكومة في مواضع كثيرة أنها بلا برنامج إنقاذ ولا رؤية جدية واضحة، بل أظهرت ارتباكا ملحوظا في كل المجالات.
وآخر ما كان ينقص الحكومة هو قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس، مع نظرة سلبية، وهم ما عللته بعدم قدرة البنك المركزي التونسي على توفر ضمانات للوفاء بالتزاماته!
لقد أتيحت للرئيس قيس سعيد فرصة حقيقية لقيادة مشروع وطني في تونس، يستطيع أن يستوعب تطلعات التونسيين، وكان يمكنه أن يجد مساحات كبيرة للتوافق بين القوى السياسية والنقابية المختلفة، ويشكل إطارا واسعا يستطيع من خلاله قيادة تونس بتوافق مريح، يساعده في تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
لذلك تبدو خطوات الرئيس قيس سعيد غير مفهومة لكثير من المتابعين والمراقبين للشأن التونسي، فبعد سجالات مع القضاء والأحزاب، فإن أخر ما كان ينقصه أن يفتح جبهة مواجهة مع تنظيم نقابي عريق في تونس مثل الإتحاد التونسي للشغل الذي يعتبره كثير من التونسيين سليلا للحركة الوطنية التونسية، وله مكانة في قلوب الجماهير، وارتبط اسم مؤسسيه الأوائل بحرب الاستقلال، كما أن له محطات مهمة واجه فيها الرئيس الراحل المؤسس الحبيب بورقيبة، وأيضا الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ورغم سلسلة الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لتهميش الاتحاد وسحب امتيازات منه، مثل الاعتراف بمنظمات نقابية منافسه وإلغاء الاقتطاع الحصري من رواتب الموظفين، إلا أنه كان من الواضح حرص قيادات الاتحاد على عدم الدخول في مواجهة مع الرئيس قيس سعيد وحكومته، والعمل على إنجاح مبادرتها السياسية.
وتنذر كل المواقف الأخيرة للرئيس قيس سعيد والاتحاد التونسي للشغل، بإن هناك مواجهة عنيفة تلوح في الأفق، سوف تزيد من تأزيم الأوضاع وتعقيدها على ما فيها تعقيد حالي!
ولا شك أن هناك قيادات سياسية وحزبية تفرك يديها فرحا بهذه المواجهة المرتقبة، التي من المؤكد أن الجميع سوف يدفع ثمنها في تونس، وخصوصا الرئيس قيس سعيد.
إن الدولة التونسية دولة محدودة الموارد، وتحتاج إلي الاستقرار والعلاقات الإيجابية مع محيطها، وتكون كما عودت الجميع واحة للأمن والاستقرار.
إن شخصنة الحكم والسلطة هي ورم من أورام الدولة. وإن العقلية الجماعية والتعاون والعمل المشترك هي أفضل الطرق للنجاح.
ينتظرُ أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد العام القادم، وسوف تكون أمامه فرصة ثمينة لكي يرشح نفسه من جديد لولاية ثانية، ويرى كثير من المتابعين والمراقبين أن المدة المتبقية له هي الأصعب في ولايته!
نتمنى الاستقرار للشقيقة تونس وأن تتجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وأن تجد طريقها لنموذج الحكم الذي يناسب خصوصيتها.