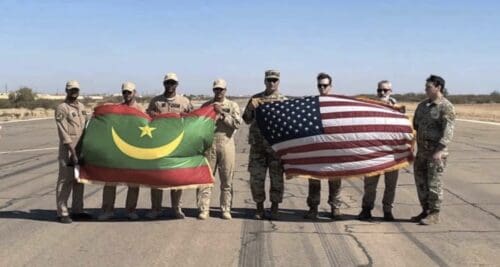طهران / إيران
كثيرا ما بادرني الزملاء خلال الأسابيع الأخيرة بالسؤال عن موقع موريتانيا في خارطة الثورات العربية المتقدة ……..
سألني الكثيرون جدا وهزلا، تعريضا وتصريحا بأن موريتاينا، ستكون من الدول التي يشملها هذا الربيع الخاص!
وفي كل مرة، كنت أرد تلميحا، تارة ….. وتصريحا تارة، مقلا في أغلب المرات، ومستفيضا في حالات نادرة، معيدا الكرة غالبا إلى مرمى محدثي، مرجحا أن يكون بلده، أسبق الى موارد الثورة – لا التهلكة لا سمح الله – من بلدي.
وتارات كنت أجدني، أمام الحاح من يهوون، المقارنات والإسقاطات والقياسات الجاهزة، اضطر للخوض، في خلفيات بعيدة، يختلط فيها التاريخي بالسياسي، والاجتماعي بالأنتربولوجي!
وكنت أفعل ذلك مكرها، فأنا ) وأعوذ بالله من كلمة أنا…) لا أحبذ التبسيط، في التعاطي مع قضايا مصيرية، وأتنكب غالبا – عن وعي تام – التنظير الجاف، المقطوع من الواقع، وأرفض – عن وعي کذلك – الإسقاط الجاهز والقياس البليد!
أحترم کل من طرقوا، تأثير الثورات التي تدق، بيد مضرجة، قلاع الحكام شرقا وغربا، وتنبؤوا – والمؤشرات لا تعوزهم دون شك – بأن الدور آت لا محالة على بلادنا!!
أعبر لهم جميعا، عن احترامي وتقديري، على اختلاف رؤاهم، وتباين وجهات نظرهم، بمن فيهم الإخوة الأعزاء، والزملاء الكرام، الذين تشرفت بمعرفتهم من قبل، وكذلك الذين، لا أعرفهم إلا من توقيعاتهم.
رأيت على الشبكة العنكبوتية المجنونة، … ذلك السيل الهادر من دعوات التغيير والثورة والإصلاح، وكلها خالصة النية للوطن، أحسبها كذلك، ولا أزكي على الله أحدا!
أحترم من يدعون الى الثورة، على الطريقة التونسية والمصرية والليبية …. وإن كنت لا أتفق معهم، في ضرورة استنساخ هذه النماذج، واسقاطها على موريتانيا … وأنا أُُكبر (بضم الألف) الداعين الى الإصلاح والتغيير، وإن كنت قد أختلف معهم في الآليات.
لا شك أن الوضع اليوم في البلاد، كما قال ذات يوم لينين ( الذي لم أعتد الإستشهاد بكلامه …مع إحترامي لمن يفعلون ذلك عادة ) وضع ثوري، تمور فيه تيارات، وتتصارع فيه رؤى، ويواجه فيه البلد، واحدة من أحلك فتراته، وأصعب أوضاعه على عدة جبهات.
مصاعب كبيرة تواجه الناس في حياتهم اليومية، … واحتقان في كل مكان، تترجمه الوقفات والاعتصامات والاحتجاجات، التي لا يكاد يخلو منها قطاع، ولا شارع ولا ساحة من ساحات العاصمة، ولا مدن البلاد الأخرى، ولا يمر يوم دون أن نرى منها نماذج جديدة!!
إنها تراكمات فرص ضائعة، أو مضيعة (؟ !) تتكرر منذ خمسين سنة.
وهي حقيقة لا تحفى على أحد … رغم قطار الحياة اللاهث، الذي لا يتيح للكثيرين منا، التمعن في ما يجري من حولهم!
قليلون لديهم الوقت للتفكير في ذلك … فالمواطن في الكبة والكزرة، يعيش يومه، مشتتا بين هموم حياة ضاغطة لاهثة، تتخللها حملات التخطيط، وشق الشوارع، وإخلاء الساحات العامة، ومواسم التسجيل والترحيل… وغيرها، من التقليعات التي تتفتق عنها يوميا، عبقريات العاملين في وزارة الإسكان والعمران، بهدف أو بدون هدف(!!) لست أدري؟.
كذلك هو المواطن في المدن الكبرى، التي تزحف عليها حياة الضواحي، مغلوب على أمره، تماما كما هو حاله، في الحواضر والأرياف، والبوادي المنسية… البعيدة، يعيش ذلك، ويحسه في حياته اليومية.
لم يعد يفقه كثيرا، مما يدور حوله، ولا يكاد يثق، في كثير مما يسمع، وقد جرب مواسم كذب عمومي متلاحقة، منذ عقود متتالية.
ليس ذلك مسؤولية شخص محدد، ولا جهة بعينها، ولا جيلا واحدا دون غيره… وإنما هو تراكم سنوات طويلة، من الفساد المتعمد، والإهمال المقصود، والتهاون الممنهج، والتسيب المدروس، …. تحول مع مرور الوقت، إلى سياسة عمومية واضحة أومعتكرة (!!) المعالم؟
وضع لا شك، يدق ناقوس الخطر، في آذان الجميع … ويصرخ في وجوهنا حميعا، مطالبا بتغيير سريع، نافذ وجذري، يجتث الداء من أصله!
…. رغم هذه اللوحة القاتمة التي تكاد تقطر دما وصديدا، أعذروني إن فاجأتكم، فأنا مجبر على التغريد خارج سرب هؤلاء، الداعين لثورة “بوعزيزية”!!!
سامحوني، فأنا سأسبح ضد ذلك التيار الجارف، الداعي لاستنساخ الثورات … لا لأننا لانحتاج إلى رفع الأصوات ملء الحناجر، مطالبين بحقنا المشروع في عيش كريم.
ولا لأننا لا نحتاج الى تغيير، لا يبقي ولايذر، أيا من الذين سبقونا بالفساد والإفساد، الذي يحلو للكثيرين هذه الأيام، رفع العقيرة بمواجهته؟!
لا لهذا ولا لذاك… أرفض استنساخ الثورات والانتفاضات، ولكن لأنني أرى، في قرارة نفسي، أننا أمام تطورات، يمكن أن تعصف، بأعز وأثمن ما لدينا، ألا وهو التعايش السلمي في كنف الإستقرار.
كلمة حق أريد بها باطل … قد يقول البعض!
وهم معذرورون في ذلك.
فقد حكم باسمها، معاوية ولد سيد أحمد الطايع سنوات طويلة، وأجهضت بذريعتها، أحلام وردية كانت تتأهب للتفتق، لتنشر أريجها الزكي، عدلا وقسطا ومساواة ومشاركة، وحياة أفضل لكل الموريتانيين!
وباسم هذه الكلمة، زج بالعشرات والمئات، بل والآلاف في غياهب السجون، وأجبر كثيرون، على قضاء زهرة أعمارهم في المنافي، مطاردين مغضوب عليهم!
وباسمها حيكت في الخفاء والعلن، الحملات التي لم تستثن، أيا من التيارات السياسية، ولا الفئات العرقية والاجتماعية في البلاد، كلهم في الهواء كانوا سواء!
لكن أليس ممكنا، أن ننظر من زاوية أخرى، ونفكر بروية وهدوء.
تعالوا معي لنكرر مع آخرين، بينهم زميلي وصديقي العزيز، دداه عبد الله، الذي حالت بيني وبينه، غابات الأمازون، أن موريتاينا ليست فعلا تونس ولا مصر… ولاهي – لاسمح الله – ليبيا!
نحن مختلفون فعلا، لأننا لا نتوفر على مؤسسات، راسخة القدم نسبيا، عمرها يقارب القرن، كما هو حال مصر وتونس، وللأسف نحن أقرب إلى ليبيا، لا بفعل طغيان التركيبة القبلية، وإنما لأن الأحكام الاستثنائية، التي تعاقبت علينا، أكلت نواة جنينية لمؤسسات، كنا نتعهدها بالرعاية والحنان، نريدها أن تكبر يوما، فإذا بها تروح، ضحية تلك الأحكام، التي سرقت ربيع شباب دولتنا الفتية، تماما كما فعل الأخ القائد، عن سبق إصرار، حين أجهز على ما كانت المملكة السنوسية، التي وحدت أقاليم ليبيا الثلاثة، قد بدأته بصعوبة، من تحديث لآليات التنظيم والحكم!
تعالوا لنقل الحقيقة…
نحن أحوج ما نكون، إلى أن نكون أنفسنا … كفانا تقليدا واستيرادا واستنساخا …. وتسييسا!
إذا كنا فعلا نريد، أن نجد ما يجمعنا، علينا أن نتصارح، وأن نعترف أن البلاد بالفعل، تمر بمرحلة صعبة، وتقف على مفترق طرق…
إما أن تبقى وتتقدم، وإما أن نثبت عجزنا، عن صياغة دولة عصرية، نتفيأ جميعا ظلالها، التي نريدها وارفة!
صدقوني، نحن بحاجة فعلا، إلى صيانة السلم الإجتماعي، بأي ثمن، لأنه بالنسبة للوطن … بمثابة القلب للجسم، إذا فسد فسد الجسم كله، وإذا صلح صلح الجسم كله….
وهذه هي القاعدة، التي يمكن أن نبني عليها، كل طموحاتنا، لأننا بدونها، سنعود سيرتنا الأولى، إلى عهود السيبة والإقتتال…
وأعرف أن الجميع، لايريدون لنا العودة، إلى ذلك الماضي التعيس!
وليسمح لي الجميع، أن أتجاسر، وأخاطب فيهم روح الوطنية، وأقول لهم بكل روح أخوية، إننا نحتاج إلى رؤية تغيير حقيقي، يلاحظه المواطن، في الكبة والكزرة قبل غيره، نحتاج لرؤية مؤشرات، يلمسها ساكن لخشب وومبو وعين بن تيلي وفصالة وانجاكو، قبل سكان لكصر وروصو ولعيون وكيهيدي وازويرات!
المواطن في كل هذه المناطق، يحتاج إلى ما يسد به، جوعه وجوع أبنائه، ويعينه على تحمل مصاعب حياة أسرته، أكثر من حاجته الى تغيير الدستور، أو تأجيل الإنتخابات أوتعجيلها..!
أقولها صراحة، …………. لكي يكون للتغيير مغزى، لا بد أن يكون واضح التأثير، في حياة الناس … في مأكلهم ومشربهم، ومسكنهم، وما حولهم من شؤون.
لهذا أرى أن الأولوية، يجب أن تكون لتحسين الظروف المعيشية، قبل الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات، وعمل المؤسسات الدستورية، رغم الأهمية البالغة لذلك.
ولكن لابد من ترتيب الأولويات، والبدء بما يمكن فعله في أمد قصير، دون إهمال التخطيط، لما ينبغي أن ينجز على المدى البعيد.
ولنكن جادين هذه المرة، يجب أن نعطي الوقت والجهد، ونتحلى بالأناة، للخروج بتصور قابل للتجسيد في مختلف المجالات، بدل الإقتصار على إجرءات مرتجلة عاجلة …. لا تفي إلا بالحاجة لبعض الوقت!!
ولكي أكون عمليا، دعوني أميز بين إجرءات سريعة وعاجلة، لاتحتمل التأخير، وأخرى تتطلب وقتا وتهيئة، ومشاورات واسعة.
وفيما يتعلق بالإجراءات العاجلة، أعتقد أن دراستها، لا ينبغي أن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، ويتعين أن تمس أسعار الغذاء، ومساطر الرواتب والأجور، وتوفير الخدمات الصحية الأولية، وسد النقص الملاحظ، في خدمات الكهرباء والماء، والعمل على تقريب المرفق العام من المواطن.
ولا يمكنني أن أقدم حصرا، لما يجب أن تشمله هذ الإجرءات، لأن الوضع، كما أسلفت كله استعجالي، ولا يحتمل التأخير ولا التأجيل بالمرة. والمطالب في هذا الصدد كثيرة ومتشعبة… ولا أريد، بل ولا يمكنني، أن أستعرض بعضها وأترك الآخر.
أما الإجرءات طويلة الأمد، فلابد أن تكون، نابعة من حوار شامل، يفضي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، على أسس جديدة، نريدها هذه المرة صلبة، والإتفاق على ضوابط للحياة العامة، ورسم ملامح سياسة إقتصادية وإجتماعية، بعيدة المدى، تستفيد من إخفاقات الماضي، دون أن تبقينا رهينة له!!
لن أدعي، أن بحوزتي وصفة جاهزة، في كل مناحي الحياة المتشعبة والمختلفة والمتباينة، وإنما لدي أفكارا عامة، ليست ملكي وحدي، فأنا أتقاسمها، مع طيف كبير من الناس، أعرف بعضهم، وناقشتها معهم في مرات كثيرة، أو قرأت لهم فيها، مساهمات متميزة، وآخرون، لا أعرفهم بالضرورة، تجمعنا الرؤية العامة، مع أننا قد نختلف في التفاصيل.
ويمكن أن تكون هذه الأفكار، جزء من زاد من يودون المشاركة في ما سماه مرة، زميلي سيدي ولد الأمجاد، موسم الهجرة الى الحوار، فهي مساهمة – قد تكون متواضعة – في حوار وطني شامل، ينبغي أن يشارك فيه الجميع، لأنه لابد أن يكون من النوع، الذي يعيد التأسيس، فنحن نريده، تمهيدا لإرساء أسس المرحلة القادمة من حياة البلاد.
وسأورد هذه الأفكار في عجالة، وبشكل عفوي، كما وردت في ذهني، دون ترتيب معين:
– مراجعة الدستور، للوصول إلى نظام متوازن، يتيح للحكومة صلاحيات أكبر، ويحد من سلطات رئيس الجمهورية، ويجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
– إلغاء غرفة الشيوخ، وتشديد شروط الترشح، للوظائف الإنتخابية البرلمانية والبلدية ( خاصة بمراعاة المستوى العلمي…)
– إنشاء هيئة عليا، مكلفة باكتتاب الموظفين، لصالح كل قطاعات الدولة، يكون بها ممثلون، للأحزاب والتنظيمات المهنية والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة طبعا، إلى الوزارة الوصية على شؤون التشغيل.
– منح مقاعد ثابتة في الحكومة للمستقلين، ولا أقصد بالمستقلين، أولئك الذين يغادرون الحزب الحاكم في المواسم الإنتخابية، “مغاضبين” إذا لم يرشحهم، ثم لا يلبثوا، أن يعودوا إلى حضنه، بعد إنقضاء الجفوة وأسبابها، وإنما أقصد بهم، تلك الشخصيات التي لا ترغب، في ركوب قطار الموالاة ولا المعارضة، أو لا تود حصر نفسها في أطر حزبية أو تنظيمية ضيقة، تحد من حريتها، وتحجم أفق نشاطها.
ومن هذه الفئة، عشرات من المثقفين والأطر، يعيشون في الداخل، كما في الخارج، من الظلم حرمان البلاد، من خبراتهم وطاقاتهم، وظلم لهم، ألا يُشركوا ( بالضم… ) في الأمر العام، لسبب واحد فقط، هو أنهم لا يسايرون رؤية معينة.
– إسناد الحقائب الوزارية التقنية البحتة ( النقل ، التجهيز، المعادن، الطاقة، الصيد ….) لمختصين يستطيعون، أن يقدموا إضافات للعمل الحكومي، في هذه الميادين، بدل وضعها دائما في يد سياسيين، نظلمهم إذا طلبنا منهم، تقديم إنجاز في ميادين، لايفقهون فيها الكثير، وتكون لهم عادة “مشاغلهم الجمة”، التي لا تترك لهم الوقت الكافي، لإدارة هذه القطاعات الحساسة.
– مراجعة الخريطة الحزبية، لا بخنق حرية التنظيم، ولكن بضبطها، بحيث يتاح للأحزاب، أن تكون تعبيرا عن إرادة الرأي العام، وقد تكون من الآليات المعقولة لتحقيق ذلك، أن نشجع في مرحلة أولى، إندماج الأحزاب فيما بينها، ومن ثم خلال مراحل لاحقة – قد يكون ذلك بعد عشرة سنوات أو عشرين مثلا – سحب الترخيص من الأحزاب، التي لا تحقق خلال مواسم إنتخابية متتالية، نتائج مقنعة في الإنتخابات النيابية والبلدية.
– القيام بعملية ” تنظيف” واسعة النطاق شاملة وجذرية، لهيئات المجتمع المدني، والتنظيمات والنقابات المهنية، نتخلص بها من إرث ثقيل (!!!!) ونحدث بها قطيعة مع الإنطباع السائد اليوم لدى الكثيرين، أن أغلب هذه التنظيمات، إنما وجدت أصلا، للعبث بكل المعايير المتعارف عليها، في مجال تنظيم العمل الأهلي والنقابي، في كل أنحاء العالم!
– اعتبار الإحتفاظ بالمقعد البرلماني، مشروطا بالبقاء في صف الحزب، الذي وصل النائب، تحت شعاره إلى الغرفة التشريعية، وبذلك يفقد تلقائيا، أي نائب ينتقل إلى حزب جديد، مقعده، مما قد يحد على المدى البعيد، من ظاهرة الترحال السياسي.
– إنشاء لجنة إنتخابية مستقلة دائمة، يختار أعضاؤها دوريا، بالتشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات المهنية والنقابات.
– منح الأحزاب السياسية، حصة في المناصب السامية في الدولة، تتناسب مع وزنها الإنتخابي، وهي مهمة، يجب أن تخضع لتريبات خاصة، تسند لمجلس مشترك، يضم ممثلين، عن عدة هيئات، قد تكون بينها مثلا، مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ووساطة الجمهورية والوزارة الأولى.
– مراجعة القانون الإنتخابي، بما يسمح بمنح ملف تسيير العملية الإنتخابية، للجنة الانتخابية، ورفع يد الإدارة نهائيا عنها، وإعادة التقطيع الإنتخابي، وحتى الإداري، وفق معايير ومعطيات جديدة موضوعية تتوخى التجانس، وتتخلى عن معايير، من زمن ولى، أكل عليها الدهر وشرب!!!
– إنشاء مجالس خبرة من الأطر المتقاعدين، وأولئك الذين يعيشون في الخارج( دبلوماسيين، مهندسين، أكادميين، إعلاميين ….)، تكفل الإستفادة من خبراتهم، وتشكل إطارا لتقديم الإستشارة للحكومة، بما يساعد في رسم وتوجيه السياسات الوطنية، في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، والدبلوماسية والسياسية والإعلامية وغيرها.
– تعيين المسؤولين السامين، وفق دفتر إلتزامات محدد، يحاسب على أساسه المسؤول، ويكون عاملا، من عوامل بقائه في منصبه، ويعتبر من معايير ترقيته، إلى مناصب أسمى.
– دراسة آلية تكفل زيادة مضطردة وتلقائية، في رواتب وأجور، موظفي وعمال القطاعين والخاص، بحيث تتناسب الرواتب والأجور طرديا، مع مستوى المعيشة، ومعدل أسعار المواد الإستهلاكية.
– نشر بيان ( يعني عدم الإكتفاء بصيغة التصريح العائمة والمخادعة بحسب الكثيرين ) بأملاك الرئيس، وأعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين عند استلامهم مهامهم، وعند مغادرتهم لها.
ويكون ذلك متاحا للجميع عبر وسائل الإعلام السيارة، يطلع عليه من يود ذلك من أمثالي من المواطنين العاديين.
– تقديم مبرر واضح ومفصل، عند كل إقالة، تطال أحد كبار المسؤولين، ويتم ذلك عبر بيان خاص، ليفرق الرأي العام، الذي كان الشخص – نظريا على الأقل – منتدبا لخدمته، بين من أقيلوا، لأسباب تتعلق بعجزهم عن تقديم أداء مقبول، أو لإرتكابهم مخالفة، أيا كنت طبيعتها ( اختلاس ، سوء تسيير، ضعف في الأداء ….)، وبين أولئك الذين أقيلوا لأسباب أخرى ( التقاعد ، الإستقالة ، الإنتداب لمهام جديدة ، أوالتهيئة لتكليف آخر….)
– عرض كل مرشح للوزارة على البرلمان لتزكيته، وفق معايير، يمكن تحديدها من قبيل، المستوى العلمي، والإلتزام الأخلاقي، والتجربة، وسعة الأفق و… غيرها، بحيث تكون الحكومة، مكونة من شخصيات معروفة، تتمتع بالخبرة، ومتفق على مواصفات أعضائها، بغض النظر عن إنتماءاتهم أوخلفياتهم، وحتى قبائلهم وجهاتهم وأعراقهم!
…… هذا غيض من فيض مما نحن في أمس الحاجة إليه، وأصر على أنها مجرد أفكار، أضعها على الطاولة للنقاش، لإثرائها وتوسيع مجالها وتعميقها، بما يخدم حوارا وطنيا شاملا، يتخلص من الأفكار المسبقة، ويدوس الحدود المعيقة.
ولا تشتمل هذه العجالة على مقترحات بخصوص عدة مجالات، لا لعدم أهميتها ومصيريتها، ولكن إما لأني لا أملك بشأنها، تصورا واضحا، كما هو حال التعليم والتكوين وضبط الحالة المدنية مثلا، أو لأن آخرين سبقوني – سدد الله خطا الجميع – إلى صياغة تصورات متكاملة للتعاطي معها.
وفي هذا الإطار، تحضرني المقترحات المفصلة، بشأن تطوير الواقع الإعلامي في البلاد، والتي صاغها أخي وزميلي، محمد المصطفى ولد أوفى، في رسالة وجهها، إلى وزير الإعلام قبل أسابيع، غداة إعلان الوزير أمام البرلمان، عن قرب إلغاء وزارة الإعلام.
وكأن الزميل أوفى، حركته المخاوف، التي ساورتني، ومعي آخرون لا محالة، ممن حكموا على أنفسهم، أن يظلوا عاضين بالنواجذ، على جمر مهنة، تكاثر أدعياؤها ومستغلوها والمسيؤون لها، ممن يحملون بيرقها…. فقد خفنا أن يكون الإجراء، الذي أعلن عنه، مجرد خطوة شكلية، ومن حسن الحظ أن ينبري أوفى، من واقع تجربته الثرية والمتنوعة، ليتحفنا بمقترحات، لا محالة، أن من شأنها أن تجعل الأمر أكثر عمقا وأبعد أثرا، وتشكل توطئة لإعلام جديد، لا “يستبله” شعبا ذكيا ومتطلعا مثل شعبنا.
موضوع آخر تهيبت طرقه، رغم أنه هذه الأيام يطرح نفسه بإلحاح علينا، يريد منا إجابات في مستوى مستقبل أمة ومصير شعب!!
إنها قضية الوحدة الوطنية.
قضية تقض مضجعي. أقولها بصراحة، فمن طبيعة مهنتي، أشفق على بلدي وشعبي، من أن يتحول – لا سمح الله – إلى مشاهد، مثل تلك التي تطالعني، يوميا، عبر حقائب الوكالات المصورة!!
ومن إشفاقي وتهيبي للقضية، أني لا أجدني قادرا، على تقديم أي مقترح من أجل التعامل معها، مع أن ذلك شغلي الشاغل، ولافخر!!!
وقد قرأت خلال الأسابيع الاخيرة، أفكارا نيرة في هذا الموضوع، لعدة كتاب ومثقفين، ولكني أعتقد، أن السفير محمد فال ولد بلال، كان أكثر من كتبوا مؤخرا في الموضوع، إحاطة وعمقا وعملية، فقد صاغ مجموعة من المقترحات القابلة للتنفيذ، قد تكون عاملا مساعدا، في وضع البلاد، على الطريق الصحيح، نحو تقديم إجابة شافية، على سؤال ظل مطروحا – تعلو بشأنه النبرة تارة ، وتخف تارة – على مدى خمسين سنة، هي كل عمر هذا الحلم الوطني الجميل، الذي لن نقبل لشمسه أن تغرب.
وهذا هو الرهان الحقيقي.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!!