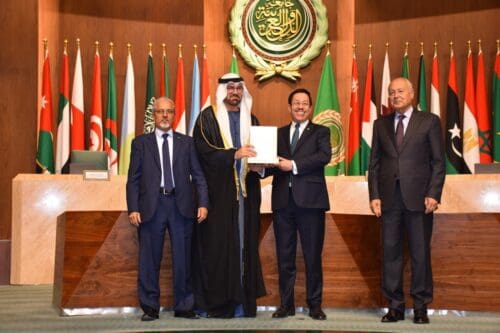بقلم السعد بن عبد الله بن بيه
باحث بمجال العلوم السياسية
تبدو ساحة الشأن العام الموريتاني منقسمة وممزقة بشكل لافت ولا مثيل له، وهو وإن كان دليل حيوية ودينامية سياسية في الظاهر، إلا أنه يعكس إحدى التجليات العميقة لحالة من التمزق تضرب أخص المستويات إلى أعمها ؛من نفس كل فرد إلى المجتمع إلى التنظيم (الدولة). فمظاهر الأزمة الشعورية والنفسية والاجتماعية والعامة ، لا تخطئها العين.والسؤال هنا أين الفلاسفة والعلماء أطباء الحضارة على حد وصف “نتشه”؟!
سنحاول في هذه المعالجة الأولية رصد مغزى ودلالة حراك التغيير العام وأثره على الواقع الموريتاني، وهو حراك يعكسه اتجاهان بارزان يقومان على تخوم أو لنقل ضفاف أغلبية كبيرة – وحقيقية- صامتة ومفعول بها ومنتحلة؛ لن نطرح سؤالا من قبيل أي الفريقين أحق بالتمثيل؟! بل سنسأل عن مدى جدوائية الفعل وكفاءة الأدوات السياسية التي يُتذرع بها، بالنسبة لجمهور الشعب (الناس)؟
ذلك أن المراقب المهتم بالشأن الموريتاني، يدرك حجم الأسباب الموضوعية والعميقة المستدعية والمحركة لأمل التغيير، في واقع لا يزال مأزوما رغم الحديث المعاد والمتواصل عن الإصلاح، دون العمل على تحقق الشروط والضمانات بله رؤية للإصلاح. نشاهد اليوم اتجاها عاما تحمل شارته بني تقليدية تمثلها: السلطة وفلكها من الداعمين، والمعارضة؛ وهي تعمل وتحافظ على اللعبة السياسية في نمطيتها وسكونيتها وتقليديتها وفاعليها، حيث السلطة تستأثر وترغب وترهب والمعارضة تناور، والدوافع معروفة ابتداء تدور حول الحفاظ على المكاسب والمصالح وجلب مزيد منها، دون أن يطمح الفاعل التقليدي هنا صاحب السلوك الاقتصادي لتغيير قواعد اللعبة السياسية، أو أن يلمس التغييرُ الموعود جوهرَ النظام السياسي – (فما الذي تضيفه على جوهر النظام الدستوري الموريتاني مثلا التوصية بتوسيع صلاحيات وزير أول يعين ويقال من الرئيس ! ) – أو يهز توازنات البني التقليدية الاجتماعية والسياسية التي أصبحت تمثل بيئة مناهضة للتغيير في الحياة العامة. لذا لا يتوقع كثير من البسطاء بسبب الحس والتجربة، وكذا المراقبين والمحللين أن يحصل قدر من التغيير العميق؛ رغم ثنائية الصراع والحوار التي تتقاسم “كقيم” فكرية وسلوك هذا النظام (السلطة – المعارضة)؛ بل إن عملية إعادة إنتاج الخطاب والقيم والمصالح لكل طرف، وقولبتها بشكل جديد وبآليات مستحدثة، هو ما ستعمل عليه السلطة والمعارضة كقوى تقليدية صراعاتها مضبوطة بحيث لا تتعدى سقف المصالح المتواضعة والضيقة لكليهما- (الاعتراف المتبادل، استقرار السلطة واستمراريتها عن طريق الاستزادة من الشرعية، واستفادة المعارضة من المشاركة في الإدارة والحظوة بامتيازاتها، وبأشكال متنوعة ومدروسة. كمقابل لمزيد من شرعنة أفعال السلطة الحاكمة )- وهو بالتالي حراك يتحكم فيه منطق الربح والخسارة الشخصيين ؛ والغائب الأكبر هنا هو ما قد نطلق عليه “المصلحة العامة” والتي هي في المحصلة تعبير عن مصالح الشعب وتطلعاته المتجاوزة بالضرورة وغير المتطابقة مع مصالح السلطة ومصالح الأحزاب في هذه اللحظة والسياق.
الحراك الثاني تمثله قوى مغايرة – حسب الشكل على الأقل- تتبنى خطابا جديدا يتوسل بسحر مقولة ومفردة “الثورة”؛ لكن –ويا للمفارقة- بقيم وأدوات كلاسيكية جدا بل وأحيانا موغلة بالتقليد ؛ خصوصا عندما تتذرع بالروابط الأولية، قبلية، وجهوية، واثنيه…؛ وبطموحات وحسابات موغلة بالشخصانية والفردية؛ حين يستقدم الشباب معه إلى سوح النضال كل تلك الغرائز التي يفترض فيه الثورة عليها؛ تمثل الثورة العربية الآن، وواقع تغير وسائل الاتصال، وتخلف الواقع المعيش، أسباب وجيهة وروافد مغذية وبجدارة لاستحقاق الثورة؛ لكنَّ قلة قليلة هي من استطاعت أن تتمثل فكر وأسلوب تلك الثورة لكن دون أن تتكلف عناء مواءمتها مع خصوصيات وحقائق الواقع الموريتاني، ودون أن تبدع منطقا جديدا تعويضيا لثغرات النقص الملاحظ في الوعي والاستعداد الثوري؛ البقية الباقية كانت بين من تخطفته حظوظ النفس وبقوة عجيبة، وأخرى بلغت بها البراغماتية حدودا لا عهد للثورة بها. ورغم أن هذه الجغرافية في حد ذاتها تشكل بيئة خصبة لوأد أو تأجيل موعد التغيير الثوري إلاَّ أن البني التقليدية (السلطة ،الأحزاب ،سدنة الوضع الاجتماعي) لم تعول على هذا الضعف الهيكلي الذي وُلِد مع الحراك الشبابي، وإنما عملت وبكل الوسائل على تلقين حلم التغيير درسا لم يتعظ به كثير من الناس. هنا تتماثل نتائج الحراكين أيضا، و يبقى الحلم الموريتاني في التغيير ضحية هو الآخر.
ورغم الفاقة إلى التغيير، إلا أن كلا الحراكين بسبب الافتقار إلى الرؤية وغياب الإرادة وفشل التخطيط، لن ينفذ حراكهم إلى لب وجوهر حالة الاستعصاء الحضاري والسياسي وفي جميع مناحي الحياة العامة ،المستدعية للتغيير والإصلاح؛ فما هو البديل إذن؟ سؤال مفتوح نتعاون جميعا على معالجته، ربما! وهو سؤال يحيلنا إلى طب الحضارة وأطبائها وهم النخب، ومقاربتي في الشأن – وكجواب أولى للسؤال – تدعي أن انتظار الوعي حتى يعم ويسري في مكونات الشعب ، سيكون انتظارا شاقا وعبثيا، فأدوات التنشئة الاجتماعية والسياسية، والتي تمثل قنوات معهودة ومشروعة وآمنة، للتربية على قيم التنوير والوعي والمشاركة والإنهمام بالشأن العام، هي أحوج ما تكون للإصلاح وإعادة التعريف، حتى يمكن الحديث عن وضع طبيعي يتمكن فيه الشعب تأكيد مطالبه والذود عنها، ومراقبة أعمال السلطة والفاعلين السياسيين، كما أن التعويل على فكرة نبل السلطة وتنازلها – في ظل غياب الشعب- عن مصالحها في التحكم والسيطرة لصالح قوى النظام وتحالفاته، يكون ضربا من الخيال، لا يعادله إلا التعويل على بني سياسية تقليدية ورَثـَّة بالمعنى السياسي، تعتاش على أزمات الوضع العام، دون أن تمتلك من الرؤية والأدوات والتمثيل للناس، ما يمكنها من فرض الإصلاح وضمان حياة سياسية طبيعية، يتم فيها التداول الذي هو جوهر “الحلم الديمقراطي“.
ملخص التاريخ السياسي الموريتاني هو: الفشل المشترك للسلط المتعاقبة والمعارضات في التعبير عن الشعب؛ من هنا دعوتنا للمراهنة على طريق بديل يقوم على تعارف وتشكل وتجميع – ليس صناعة- نخب جديدة (ثقافية ،سياسية ،مالية …) تحمل قيما جديدة، وتؤمن بمشروع جديد للنهوض الوطني، ففي هذه اللحظة تلوح فرصة حقيقية أن يمثل الشباب الموريتاني “مادة” هذه النخب، وأن تكون الكفاءة العملية والفكرية والأخلاقية أدوات لمشروعه، لعله يمثل قوة بديلة، تعتمد على قيم الدين الحق، والعقلانية والعلم والتنظيم، هدفه الخروج من لحظة اللامعنى والخواء الذي تعرفه هذه البلاد منذ عقود.