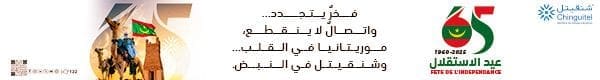لا أجد بداية تليق بالحديث عن محمد بن عيسى، في ذكرى غيابه الجسدي عن دنيانا، فالرجل ليس مجرد اسم عابر في سجل السياسة أو الثقافة. خلال نصف القرن الماضي، بل هو تجربة حياة متكاملة، تركت آثاراً وحققت رؤى، تجربة تتقاطع فيها المعرفة العميقة بطبائع الواقع، مع لمسات دافقة من حسّ إنساني رفيع، وهي أيضاً تجربة البقاء الدبلوماسي، المسنودة بالمعرفة والانفتاح والوطنية، مع روح الفنان وروح المثقف الملتزم. لذلك فإن حديث الذكرى عنه يطول ويتشعب، فوراها شخصية باذخة متعددة، متكاملة الملامح، كأنها مرآة عاكسة بعدة زوايا، تلتقط في كل زاوية منها انعكاساً مختلفاً لروح واحدة واسعة.
منذ بداياته كان محمد بن عيسى مشروعاً دائماً في التحوّل الدائم، من تلميذ مغربي طموح في القاهرة في خمسينيات القرن الماضي، إلى صحفي لامع في إذاعة “صوت إفريقيا” في طنجة، ومنها إلى مسؤول حكومي ودبلوماسي فاعل ثقافياً في حواضر القارات، وصانع الأفلام الوثائقية، ليحفر عميقاً في الذاكرة الجماعية للأفارقة، والعرب، والمتوسطيين.
وأنا أستعيد صورته اليوم لا أجد أبعد من ثلاث محطات تختزن هذه الشخصية الغنية، وتجعل الحديث عنه أقرب إلى استعادة طيف حيّ من زمن كنا نعتقد أنه قد رحل.
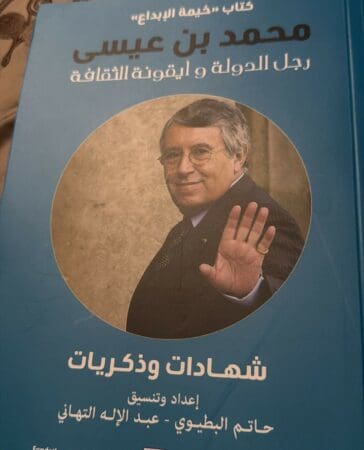
المشهد الأول: حكاية رواها لي محمد بن عيسى أكثر من مرة وهو يحدثني بنبرة المندهش من لحظة اكتشاف. قال إنه في أوائل سبعينيات القرن الماضي، كان في المنزلة (جنوب موريتانيا)، يعد فيلماً وثائقياً عن الصناعات الجلدية التقليدية في هذه المنطقة. وهناك، التقى شيخاً جليلاً، جالساً وسط أكوام من الكتب والمجلدات، داخل مكتبة تشبه البحر في امتداده وهيبته. وعندما علم الشيخ أن الصحفي الذي أمامه مغربي، اقترب منه وهمس بنبرة صوفية عميقة: “نحن أيضاً أصولنا من هناك”.
جملة صغيرة لكنها بقيت في ذهن بن عيسى، تعيد رسم الجغرافيا على ضوء دوائر الدم، لا الحدود الموروثة عن الاستعمار، وتقفام في نفس الوقت، السرديات الاستعمارية التي رسمت صورة المغرب كـ”جارٍ عدو”. لقد وعى الرجل مبكراً أن هذه الأمة إنما يربط بلاد المغرب أعمق من السياسة، وأوطد من الخرائط.
لم ينسَ بن عيسى هذه اللحظة المفصلية، بل جعل منها دليلاً مرشداً في زياراته اللاحقة إلى نواكشوط وهو وزير للثقافة ثم للخارجية بعد ذلك، ليدعّم بها مساعيه من مقامه لبلوغ الحاضر والغائب، أن الحضور لا ينضب إذا استمعت له المحبة والتعاون.
المشهد الثاني: لم يكن صورة، بل صوتاً. ذلك الصوت المهيب الذي عرفه الموريتانيون عبر الإذاعة الوطنية في بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، حين زار نواكشوط وزيراً للثقافة في أولى التوأمات المغربية. في تلك الزيارة استحضر التاريخ بكل عنفوانه، وراح يروي كيف أن المغاربة والموريتانيين تقاسموا سرديات الانتماء منذ كانت تندوف محطة من محطات الحج إلى نواكشوط، إلى أن واصلوا إلى تخوم الأندلس.
في تلك المناسبة ذكّرنا بن عيسى بالهوية المركبة، بالتاريخ الذي يعيد نفسه، لا على شكل ماضٍ غائب، بل كافٍ مفتوح يحمل بين طياته الدروس والعبر. خاطب الموريتانيين بوجوههم المتعددة، في الصحراء وعبور الجبال والأنهار، وامتدت إلى أوروبا يوماً في وحدة واحدة، بل في مشروع مشترك تصوغه الأجيال. وتعدد قراءاته مؤكداً أن الهوية ليست قدراً جغرافياً، بل مشروعاً مشتركاً تصوغه الأجيال.
المشهد الثالث: فهو الصورة التي اختزنتها الأجيال عن محمد بن عيسى، صانع المحتوى الثقافي، ومهندساً للدبلوماسية الناعمة. كانت “أصيلة”، البلدة الصغيرة على المحيط مسرحه الكبير، حيث استطاع أن يجمع العالم إلى ضفافها. فانبرى جيل عربي طالما شاهدناهم في طفولتنا على الشاشة الصغيرة، وقرأنا لهم، إلى كتاب كبار مثل الطيب صالح، وأميل حبيبي، ومحمود درويش، وجورج جحا، وبلند الحيدري، وأحمد عبد المعطي حجازي، وأحمد المديني، وغيرهم كثير من كبار الفنانين والكتاب والمفكرين والساسة، الذين يعتبرون من العقول البِكرة، المنتمية للقارات الخمس.
لقد فهم بن عيسى أن الثقافة ليست ترفاً، بل وسيلة مقاومة وبناء، وأن المدينة الصغيرة، يمكن أن تكون قلب العالم، إذا أحسنت استعمال قوتها الرمزية. انطلاقاً من هذا المبدأ، وضع بن عيسى مدينته “أصيلة” على خارطة الذاكرة الثقافية العالمية، وصارت ملتقى تتلاقى فيه الروافد والأنهار، التي تتبع من خرائط العالم، في مشهد لا يصنعه إلا العالِمون الكبار.
علّمنا بن عيسى أن المثقف لا يكتفي بالتنظير، بل يصنع الفعل، وأن الدبلوماسي لا يكتفي بالبيانات، بل عليه أن يبني جسور المعنى بين الثقافات والشعوب، وأن السياسة حين تتشح بالثقافة المنفتحة، يمكنها أن تترك أثراً أعمق من المواقف الظرفية.
واليوم، وأنت ترقد في حضن مدفن الزاوية العيساوية في “أصيلة”، متدثراً بالرحمات المرجوة، ومعرفتنا بجميلك ومآثرك، نرفع إليك تحية الوفاء، وندعو لك بالرحمة.
نم مطمئناً يا محمد بن عيسى. لقد تركت لنا أثراً لا يمحى، وصنعة ثقافية ستتربها الأجيال من بعدك، وتذكرك بها إلى الأبد.