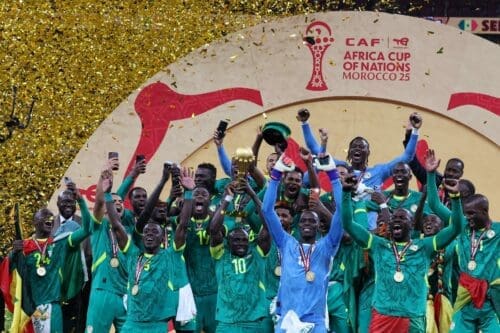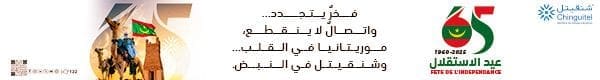في السابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2019، أي قبل أشهر من الآن، شاركت في اجتماع جهات التمويل الخاص بمتابعة تنفيذ التزامات الممولين لصالح مجموعة دول الساحل الخمس، وهي الإلتزامات المعلن عنها خلال مؤتمر قمة المجموعة المنعقد في نواكشوط في 06 ديسمبر 2018.
بينما كنت أستعرض قائمة البلدان التي قدمت التزامات، استوقفني اسم بلد ما عهدته جهة تمويل، إنها روندا التي تبرعت بمبلغ مليون دولار لصالح شقيقاتها في مجموعة دول الساحل الخمس.
فكرت مليا في هذه الحالة التي أمامي، بلد شهِد – قبل قرابة عقدين من الزمن – حربا أهلية ضروسا أسفرت عن إبادة جماعية لمئات الآلاف من الرونديين والرونديات، ورغم ذلك استطاع خلال هذا الظرف الوجيز ، لا أن يضمد جراحه فحسب، بل أن يشفي تلك الجراح العميقة والنازفة، فأعاد بناء وحدته الوطنية وأرسى قواعد الأخوة والتسامح والتضامن بين مكونات شعبه، ليحل النمو والازدهار محل الضغائن والأحقاد والتنافر والتدابر، وحقق بالإصلاح نهضة اقتصادية شاملة، من خلال اعتماد إصلاحات سياسية ومؤسسية جوهرية.
لهذه الأسباب أصبحت روندا رقما صعبا في المعادلات إلإقليمية والدولية يحسب لها ألف حساب، وأضحت فعلا لاعبا رئيسيا لا يمكن تجاهله في كل هذه المحافل الدولية، دبلوماسيا واقتصاديا.
ومما زاد تعجبي وإعجابي بالظاهرة الروندية التي ما زالت أنموذجا فريدا في إفريقيا، أن هذا البلد لا يتوفر على مقدرات طبيعية لافتة ولا قاعدة صناعية، ولا مستوى رفيع من تقدم البحث العلمي، أو موارد بشرية نخبوية كبيرة، ولا تتوفر لدى شعبه درجة من الوعي والتطور الفكري يمتاز بها الرأي العام، فليست لدى روندا أي من هذه المقومات.
كيف إذن إستطاعت روندا الأمس أن تصبح روندا اليوم ؟
ذلك هو السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه.
يجب أن لا نذهب بعيدا في البحث عن الجواب لأنه بسيط وقريب جدا، فقد من الله على هذه البلاد بأن رزقها قائدا وطنيا فذا يحمل رؤية متكاملة واضحة وشاملة، وطموحا كبيرا لبلده وعزيمة إصلاح لا تتزحزح، لا أكثر من ذلك ولا أقل، وهذا هو السبب الأوحد لهذه النهضة، بل هذه هي كل مبررات وأسباب هذا الإقلاع، وتلك القفزة التاريخية إلى مصاف الدول المانحة، سواء صدقنا ذلك أم لم نصدقه.
لا أخفيكم أنني بعد صدور نتائج انتخابات شهر يوليو 2019 الرئاسية في بلادنا كنت -وكثر هم الموريتانيون الذين يشاطرونني هذا التوجس- من الظانين أن شيأ لم يتغير، وأن فخامة الرئيس السابق سيواصل إدارة شؤون البلاد من وراء حجاب، وقد تأسس هذا التخوف عندي على أمور كثيرة يدركها الجميع، وربما كان من دواعي ذلك أن الشفيق مولع بسوء الظن كما يُقال.
جاءت واقعة معركة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لتنسف كل تحليلاتي وتقلب كل مسلماتي رأسا على عقب، فسرعان ما تبادر لي أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واع كل الوعي لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد والرهانات الوطنية والإقليمية والدولية المرتبطة بها، وأنه سيمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة وفقا لكلام مأثور عن أحد أولياء الله الصالحين إذ يقول «من يعرفني يعرفني وحدي» إلا أن أسلوب القيادة لديه كان مبنيا على ثوابت راسخة في طبعه مستمدة من تربيته الاجتماعية، قوامها التأني والتريث والتحوط والاتئاد ودماثة الخلق والتواضع، ولم يكُ على استعداد للتخلي عن هذا المنهج، واستبداله بنهج المشفقين على البلد ودعاة التسرع، فهو يزن قراراته بميزان الحكمة والتعقل، ولا يتخذها إلا في الوقت الذي يراه مناسبا بعد ضمان نضجها على «جنة هادئة».
حسم قرار مرجعية الحزب أثلج صدري، وأكد لي أن موضوع ثنائية عقل القيادة حسمت، وأن ليس هنالك رئيس في الظل وآخر في العلن، وهذه القناعة تولدت لدي بعد هذا القرار بالذات وليس قبله بالرغم من الرسائل الإيجابية العديدة التي سبقته على مستوى التعاطي مع الشركاء السياسيين، خاصة في أقطاب المعارضة، حيث تم الاعتناء بهم، وإنزالهم منازلهم، فقد عزوت ذلك أكثر للبعد التربوي والمشرب السلوكي للرجل، أكثر من كونه رسائل سياسية، ولو أن هذا البعد كان هو الآخر جليا حاضرا.
كانت إزالة اللبس بخصوص إشكالية «نصف الرئيس» و«الرئيس الكامل» كافية لإقناعي بأن البلاد أخذت بالفعل مسارا إصلاحيا لا رجعة فيه، لكني لم أتوقع أن يرقى هذا الإصلاح إلى أن يصل درجة المساءلة عن الخروقات الفادحة التي تمت خلال العشرية الماضية، والسعي على الأقل إلى إنارة الرأي العام الوطني بشأنها، فجاء قرار إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية ليوضح أن الإصلاح سيكون عميقا، وأنه أبعد ما يكون عن السطحية، ثم توالت الإجراءات المتسارعة لتؤكد ذلك وتعززه كقرار القضاء بوقف المتابعات القضائية للخصوم السياسين وتخصيص مبالغ معتبرة من موازنة الدولة للقضاء على آثار الغبن والتهميش، وإسناد تلك المهمة لجهاز أنشىء خصوصا لهذا الغرض، وغيرها من الإجراءات التي تمت في وقت وجيز .
تمنيت وتضرعت إلى الله أن يستطيع هذا القائد الذي يبدو أنه من طينة جديدة من الرؤساء أن يكمل في سلم وسلام وأمن وأمان مأموريتيه، ويسلم سفينة البلاد إلى قائد مدني بالمفهوم التقليدي، تفرزه انتخابات شفافة ونزيهة ليواصل بعده مسيرة التقدم والنماء.
بالمناسبة لست من الذين لديهم مآخذ سلبية مطلقة على حقبة قيادة قواتنا المسلحة للبلاد، فجيشنا الوطني هو أكبر رموز سيادتنا، وقاد البلاد في فترة عصيبة وطنيا وإقليميا ودوليا، من خلال رجال لا نشك في حسن نيتهم تجاه الوطن، وإن كان منهم بالفعل من ارتكب أخطاء فادحة عفا الله عني وعنه، لكن نلتمس له حسن الظن، مرجحين أنه ما ارتكب ذلك عن سوء نية، وإنما عن خطإ في التقدير، على كل حال نحن كمدنيين، خاصة نخبنا المثقفة كنّا شركاء بارزين في كل ما حصل بخيره وشره، فقد كنّا رؤساء وزراء القادة العسكريين وزراءهم وولاتهم وسفراءهم ومستشاريهم ومدراء المؤسسات ورؤساء المشاريع في عهدهم، وكمحصلة موضوعية يمكن أن نقول أن هؤلاء القادة وفقوا في الكثير وأخفقوا في الكثير، لكن هنالك نجاحان إن لم نسجل لهم غيرهما لكانا كافيين للشفاعة فيهم، ألا وهما أنه خلال قيادتهم للبلاد عرفت كل الدول المحاذية لنا صراعات مسلحة في وقت ما من هذه الحقبة، وكانت موريتانيا هي الاستثناء الوحيد (المغرب، الجزائر، مالي، السنغال).
أما الإنجاز الثاني ،فقد كنّا من نوادر بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي لم يحدث في يوم من الأيام أن تأخر دفع مرتبات موظفيها طيلة كل هذه الفترة عن الموعد المعتاد.
كان طموحي للبلاد يقف عند تسليمها من طرف فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لرئيس منتخب ديمقراطيا، بعد عشرية يطرزها بالإنجازات تجعل منا بلدا صاعدا، لكن لما رجعت إلى الوتيرة التي تتلاحق بها الإنجازات، خاصة مع تعدد ورشات الإصلاح والحضور الكبير والمتزايد على الساحة الإقليمية والدولية، وثقة شركاء التعاون الدوليين والإقليميين الذين أصبحوا يجعلون من البلاد قبلة لهم، وكذلك الآفاق الواعدة لمقدرات البلاد من الموارد الطبيعية، أصبحت أرفع سقف طموحاتي لإنجازات فخامة الرئيس خلال العشرية الجديدة، وهو الذي يبدو أن لديه كفاءات قيادية نادرة، ويقضي هذا الطموح بأن تصل هذه الإنجازات مستوى عاليا، يفوق كل التصورات والتوقعات، إلى درجة تجعل الطبقة السياسية عندنا تجمع بمعارضتها قبل موالاتها، وبهما معا في نهاية العشرية، على تعديل دستوري يقضي بإستمرار فخامته لمأموريات أخرى، ليس ذلك لعدم الرغبة في التناوب الذي هو فضيلة لا شك في أهميتها، وإنما لعدم وجود الأفضل، تماما كما فعل الرونديون في نهاية المأموريات الدستورية للرئيس ابول كاكامي، وهنا أتذكر حديثا جرى بيني قبل سنوات، مع رجل أعمال تركي جمعتني وإياه إحدى الرحلات الجوية، حيث قال لي إنه من حزب معارض في بلده لكنه في كل الانتخابات الرئاسية يصوت شخصيا للرئيس أردوغان، فتعجبت من هذا الموقف، وسألته عن السبب فقال لي: منذ حكمنا هذا الرجل وأرباحي في تصاعد مستمر .
بقلم: أحمد سالم ولد أحمد
* رئيس دائرة البرامج الزراعية والبيئية وتغير المناخ المنظمة العربية للتنمية الزراعية
الخرطوم -السودان