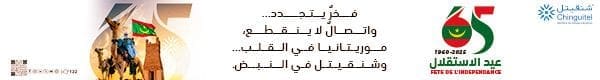لم أقرأ بعد كتاب « الرحالة: هكذا رأيت العالم » لصديقي العزيز سامي كليب، وإن كان لي شرف التقاط صورة الغلاف خلال زيارة يتيمة لرئيس فرنسا وقتها جاك شيراك لموريتانيا، شهر سبتمبر من عام 1997.
تعرفت على سامي عبر الهاتف لأول مرة وكلانا يخوض من موقعه تجربة صحفية تعمق هو فيها ونال رتبا رفيعة، ويسجل لي أنني مارست الصنف الإذاعي من الصحافة لسنوات، مراسلا مبتدئا لإذاعة فرنسا الدولية في قسمها العربي، إبان تأسيسه عام 1989.
بعد ذلك جاء شيراك لموريتانيا وكان سامي مراسلا مجدا يزاوج بين أصناف الصحافة الثلاث: الإذاعة والتلفزيون والكتابة في جريدة « السفير »، فكان يصور ويكتب ويقرأ ويعلق ممارسا المهنة المتعبة بحواسه الأربعة، إضافة إلى حماسه وحدسه الذي لا يخيب.
 لا زلت أتذكر أن الحماس أخذ العديد من الصحفيين الفرنسيين الذين تذكروا موريتانيا يوم كانت جزءا من مستعمراتهم في وقت كان جنودهم يمتطون الجمال، ولعلهم « تبدونوا » إذا جاز التعبير، فبدل أن يمدّنوا البلاد ويبنوا مثلما فعلوا في داكار والرباط والجزائر، أبقوا موريتانيا مربعا للحنين والأطلال، ومستعمرة لاستنزاف الخيرات المعدنية، لا للبناء والعمران.
لا زلت أتذكر أن الحماس أخذ العديد من الصحفيين الفرنسيين الذين تذكروا موريتانيا يوم كانت جزءا من مستعمراتهم في وقت كان جنودهم يمتطون الجمال، ولعلهم « تبدونوا » إذا جاز التعبير، فبدل أن يمدّنوا البلاد ويبنوا مثلما فعلوا في داكار والرباط والجزائر، أبقوا موريتانيا مربعا للحنين والأطلال، ومستعمرة لاستنزاف الخيرات المعدنية، لا للبناء والعمران.
امتطى سامي وقتها جملا ليسجل من على راحلته نهاية قصته التلفزيونية لقناة « أل بي سي » اللبنانية، وطلب مني التقاط صورة، وما كنت أظن أن تلك اللقطة الشاردة ستحظى بتلك المكانة في غلاف كتاب هام يختصر جزءا مهما من عمر صحفي، ومن تجربته الحياتية الفريدة.
التقينا بعد ذلك مجددا في أكثر من بلد، كنت خلالها مساعدا في جوانب من إنتاج بعض حلقات برنامجه المميز « زيارة خاصة ».
قضينا أياما وليالي في ضيافة الصحراء، ونمنا معا تحت السماء المفتوحة على سطح بيتنا تحت نجوم « النباغية »، وإنني في إحدى تلك الليالي المقمرة المشبعة برطوبة الصحراء خفت عليه لسع عقارب أخرجها رذاذ المطر من مخبئها السري.
تسامرنا أحيانا في شارع مفتار في باريس وهو يروي بنباهته وبلسانه العذب عن ابن عمنا الصحفي محمد الباهي، وعن كنوزه المعرفية وبداوته المتأصلة حتى وهو في قلب باريس.
تلاقت حظوظنا وتقاطعت خطوط رحلاتنا لنلتقي مجددا في دمشق وداكار وبيروت، قبل أن يدعوني ذات مساء لحفل زفافه، فيسقطني على غفلة مني صريعا في هوى قريته الجبلية الرائعة وفي أهلها الموحدين الطيبين.
من شرفة يبت أهله في « نيحا » رأيت القمر كما لم أبصره من قبل، وهو يباغت أشجار الأرز والتفاح بشعاعه الفضي ويصنع لوحة ضوئية ما زلت إلى اليوم حائرا إزاء جمالها الفريد.
تعرفت على والدته الطيبة عفت فرحان كليب التي روت كيف أنها متأصلة من عائلة معظم رجالها قضاة مذهب، يحمون القيم ويحافظون في مجتمعاتهم على توازن مهدد على الدوام، أحسست بعزتها واعتدادها وبحنانها الذي يفيض على العائلة والمحيط والقرية والأصدقاء، وآلمني فراقها بعد ذلك بسنوات.
في بيت هذه العائلة النبيلة وبين إخوته الكرام أحسست أن جزءا من روح العرب وكرمهم لا يزال حيّا يرزق، في بلد تقطعت أوصاله بسبب الفرقة وسوء التفاهم وربما الكراهية.
لم تفاجئني أبدا مواهب سامي المتعددة، فقد كان على الدوام مستكشفا، وكاتبا أنيق العبارة، وبإمكانه، وهو الصبور المثابر، أن يصل ببحوثه إلى مداها الأقصى، وليس غريبا أن تكون التجارب التي اختزنها في « الرحالة » هي ثمرة موهبة وجهد نعتز بها جميعا نحن قراؤه ومحبوه.
جاءت الحرب السورية بكل أهوالها وتجاذباتها وظل سامي صاحب موقف، ولكنه ظل في نفس الوقت يحترم الرأي الآخر المخالف، صبورا على من يكيل له التهم، مقتنعا بصواب رأيه رغم كل ما يمكن أن يقال في هذا الجانب أو ذاك.
لا ينبغي أن أنسى أن سامي كان له في كل يوم حديث على شاشة لبنانية أو في إذاعة أو رأي في صحيفة، وأعتقد جازما أنه بتفرغه لكتابة سفر عن الرحلات التي أغنت تجربة حياته أراد أن يغسل روحه وأن يتطهر ليكشف عن بعض ما في جعبته من كنوز ثمينة، وذلك لأجل أن نستمتع نحن بأجمل ما يبحث عنه القارئ النهم في ثقافة الآخرين ونمط حياتهم وأشكال وعيهم بحقائق هذا العالم، ولا غرو أن يسلك سامي طريق ابن بطوطة الذي كاد يصدّق ذات يوم أن له ضريحا يزار في بلدته طنجة، وهو الذي كان وهب حياته لغبار السبيل وأثبت أن السفر ليس الذي كان دوما « قطعة من العذاب »، قد يكون أحيانا أكثر لطفا وأشد إثارة ثم ترك لنا أثرا يعوض عن التعب والإرهاق لنقل لُب البلدان والأمصار التي زارها وقدم لنا ما فيها من الغرائب والعجائب.
صديقي العزيز، دمت كاتبا ومسافرا وبدويا حقيقيا، فقد حولت أسفارك إلى متعة حقيقية لنا جميعا بعد أن رأينا العالم بعينيك، وبعد أن ذللت كل السبل من أجل أن نستمتع صحبتك بها.