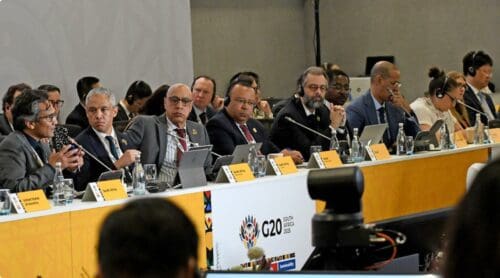باحث بمجال العلوم السياسية
“لا يوجد أقوى من فكرة جاء وقتها” حسب (فيكتور هيكو)، وأظن أن فكرة دور الشباب الموريتاني في التغيير جاء وقتها، من خلال الاهتمام والمشاركة في تأميم الشأن العام، والذي أصبح يدار بطرق وبسياسات تجعل من الصعب معرفة من يقررها، ومن هم الفاعلون الحقيقيون، وهو ما يطرح وفي العمق أسئلة تتعلق “بالسيادة” وحقيقة الإمكانات والوسائل ؛ ليس من المبالغة أن سؤال كيف نحكم وكيف تدار شؤوننا؟ أصبح سؤالا مطروحا وخطيرا في هذه اللحظة، وهناك دوما شيء من الخطأ في الإجابات المتعجلة والسطحية ، والحقيقة أن هناك لا يقينا يستبد بعقل كل باحث ومهتم جاد بهذا السؤال ،رغم أن حقيقة النظام – ( الدولة بالمعني السطحي والشعبوي والمختزل في السلطة) – لم تتغير لا في سياساتها ولا في نخبها ، بل إن تراجعا كبيرا لحق بأداء النخب الرسمية والمعارضة، واستمر حتى اللحظة.
فالنخب الحاكمة اليوم تعاني من سوء التدبير(التبذير والفساد)، وضعف الكفاءة، وضعف تعبئة الموارد وتدني المردودية، فالعمل الحكومي اليوم أصبح قابلا وخاضعا للملاحظة والقياس أو هكذا يجب، وإلى جانب الحكومة تعاني نخب المعارضة أولا في مصداقيتها ومشروعيتها– وهو الأخطر – والفشل في أن تمثل بديلا، ولا تتوقف أزمتها هنا بل تتعدي إلى ترهل التنظيمات وتوقف الفكر وسطحية الخطاب وتخلف وبدائية وسائل التواصل والتنشئة ولا يدانيها هنا إلا ما يعرف بأحزاب الأغلبية – أية أغلبية؟! سؤال مطروح ينتظر الإجابة عن كيف تشكلت هذه الأغلبية وماذا يجمعها وما موقعها في نسق السلطة ودورها في صناعة القرار -، هذا عن قطبي النظام السياسي الموريتاني الحاكمين للسلطة والمعارضين لأجلها، وليس عن تنظيمات أخرى تسمي نفسها وهي – الغالبة – أحزابا وهي مجرد “عوالق” انتهازية تعبر عن حالة التردي العام للنظام السياسي الموريتاني بالمعنى الواسع ، وهي أقل من أن يتوجه إليها عاقل بكلامه؛ إلى جانب هذه النخب المتغلبة والمسيطرة على موارد الدولة ومصائر البشر يوجد مكون بشري هام لم يتعرف بعد على حقيقته ويراد له أن يكون ( مصقول الوجه ،ظمآن الشفتين ، لا يعرف نفسه ولا رسالته) حسب (إقبال) ، إنها فئة الشباب والتي هي فئة مختلفة تماما عما تصفها وتصمها به الإيديولوجية الرسمية دوما من العجز والتكبر عن الخدمة العامة وعدم التأهيل والخبرة – والكلام هنا بالطبع ليس مرسلا على عواهنه- لمعرفتنا بهذا الشباب في الداخل والخارج و فكريته وتوجهاته ومهاراته النوعية ، فهو يمتلك من الطاقة والحيوية والكفاءة المعرفية والعملية الكثير ،فضلا عن جدة الخطاب وحداثته والتمكن من وسائل وآليات إدارة الشأن العام، ولكنه مازال يعاني من عوائق موضوعية وبنيوية لم يعرف أو لم ينتظم بعد ليعرف كيف يتخطاها ، وعلى رأسها سياسات ممنهجة تواجهه بالتهميش والإقصاء وعدم الاعتراف حد الكفر به، وهو اليوم لديه من التطلعات المشروعة ما يجعله يغادر التفاهة ويجعل من نفسه طرفا فاعلا وخيارا بديلا.
وأخطر ما يعاني منه الشباب اليوم كقوة وطنية جمود النظام السياسي الذي لا ينفك يعيد نفسه ، فكل محاولات التغيير بدءا بالانقلابات ومرورا بالانتخابات وانتهاء بالتعيينات … هي عمليات تحاول دوما إعادة الانتشار لنفس النخب والقوى المسيطرة والمحتكرة لإدارة الشأن العام منذ 1978 إلى اليوم والتي مثلت سدا منيعا أمام تداول سلمي للسلطة وتبادل للنخب على مواقع المسؤولية وإعادة بناء منطق الدولة بديلا عن منطق أكثر انحطاطا يتكأ على المصالح والاعتبارات الضيقة ، إنها لاعقلانية مشهودة ولا تحتاج التدليل عليها؛ وهو وضع نتج عنه انسداد أفق التغيير وتكلست فيه قنوات المشاركة والتعبير فاحتكرت وسائل الإعلام العمومي وغابت التشاركية في التسيير، والمساواة في الولوج إلى المرفق العام ، وبموازاة سيادة هذه السياسات على مستوى البنية الرسمية وشبه الرسمية، عانى الشباب ويعاني من انتشار وتجذر ثقافة تقليدية تسودها التقية ومحاباة الحكام فتعلى من شأنهم على حساب الناس (المواطنين) وتجعل من الدولة ملكا شخصيا للحاكم وعترته ومواليه، وكله بتزكية مثقفين قبلوا دور الأداة في يد السلطة ودرست عليهم الخطوط الفاصلة بين الدعم والموالاة والمصلحة العليا للوطن. وأصبح ممثلي هذه الثقافة يتسابقون إلى تقديم الطاعة والولاء بعيدا عن أي نوع من أنواع المساءلة للنظام في حالة فشله أو نجاحه كمقرر عن الأمة .
وهو ما سد الباب أمام الشباب ووجد نفسه في مأزق لا يحسد عليه إذ تطلب منه الأمر حفاظا على الوجود، تركيب نوع من الولاء المزدوج فهو مطالب بتقديم آيات الولاء والطاعة ليس لحكامه فحسب وإنما لهذه البنية الثقافية السلبية ورموزها للاعتراف به ومنحه شهادة حسن سلوك وسيرة ومن ثم تقديمه للسلطة ، فقد أصبح الشباب مهما كانت مؤهلاته محتاجا إلى زعيم قبليي خرف أخرق يزكيه ويدعمه عند الدولة ، وأصبحت هذه الثقافة “ميكانيزم” بديلا عن الاستحقاق والقانون وأصبحت عتبة أولى ليحظي الشاب بدخول البلاط ويشرف بتقديم المحاباة والسكوت عن النقد ليحقق وجوده وأحيانا ضروراته الحيوية للعيش كآدمي، وهذا التحالف بين قيم التقليد البائدة والدولة الوطنية الظالمة قتل كل إرادة لدى الشباب كفئة تملك مشروعية المساهمة في التغيير والتقدم بل وساهم في نشر ثقافة سلبية بين صفوفهم سماتها اللامبالاة والخضوع وأحيانا الاضطرار للعب أدوار النفاق والتزلف ؛ إنه توصيف مؤلم لكنه الحقيقة في أدنى مراتب التوصيف، ولكن ومع هذا نلاحظ مسرورين في المدة الأخيرة بدء معالم وعي يتشكل لدى مستويات هامة من الشباب والمواطنين بخطر هذه الظواهر ، والتي في ظل استمرارها أصبح الحديث عن تمثيل المواطنين وعن قرارات حكومية رشيدة وديمقراطية لا معنى له .
لقد أصبح لزاما على الشباب الموريتاني اليوم أكثر من أي وقت مضى أن ينتظم بشكل حقيقي وراء مصلحة بلاده التي هي مصلحته ، وأن يعتنق أكثر الأفكار – لا نقول راديكالية – وإنما قدرة على الإبداع والبناء ،متسلحا بثقافة الأصل والعصر ،مؤسسا بنيانه على أساس متين من فهم دينه وثقافته وحضارته ، ومتسامقا بهذا البنيان ليصله في غير ما تضاد ولا تنافر مع ثقافة عصره ،في حقوق الإنسان : في الحرية والعدالة والمساواة والتنمية / والديمقراطية : ثقافة ومضمونا لا قشورا وإجراءات / و التكنولوجيا : علما وفهما وتسخيرا؛ بهذا وحده يجعل من نفسه بديلا عقلانيا لنخب في أغلبيتها لا هم لها – والتاريخ شاهد – غير كنز المال من حله أو غيره . لذا نحن بحاجة ماسة إلى تصدر جيل جديد للمشاركة في قيادة الشأن العام متسلحا بثقافة مغايرة ، وليشيد البنيان على أساس من قوة العقيدة والإرادة وقوة العلم والأخلاق والعقل ، وقوة التجارة والاقتصاد ، وقوة الثقافة والدبلوماسية والحوار ؛ ولذا على الشباب اليوم وبشكل عملي وحقيقي أن يكشف عن وجهه ومطالبه المشروعة في العيش الكريم والنظام العادل والشفاف ، ويجعل من نفسه رقما صحيحا وصعبا في معادلة الواقع السياسي والاجتماعي ،وسبيل هذا الانتظام هو التعارف والتعاضد من أجل التحاور والتفاوض مع النخب الأخرى وإعادة الأمور إلى جادة الصواب بصولجان قوة التنظيم والكلمة ومضاء العزيمة وصفاء الطوية وهو بداية إنقاذ الكل السياسي والبلد من مصير التشرذم والتفتت والتخلف.
إن الشباب ومختلف الفاعلين النزهاء وغير المتلطخين بالولوغ في الفساد مطالبين بصياغة أجندة سياسية ذات طابع استعجالي تروم محاصرة الفقر والحرمان من الفرص وتدني مستويات الحياة وبث الروح الأخلاقية في الحياة العامة لتكون الأعمال ذات دلالة ، ومعالجة شكلية المؤسسات القائمة (الحكومة والبرلمان والقضاء…) وفك التواطئ بين المقرر العمومي وأصحاب المصالح الخاصة والضيقة.
ومطالب التغيير الآنية واضحة يلخصها:
ا/ البحث عن حكومة تمتلك من الكفاءة العلمية والعملية والنزاهة ما يمكنها من صوغ برنامج عمل يروم بناء الازدهار والعدالة ، هاته الحكومة لا يصلح فيها لون واحد بل يجب أن تكون من مواقع ومراكز مختلفة ( تكنوقراط – مستقلين – و أحزا ب) وأن يدخلها عنصر الشباب بتمثيل يناسب حجمه ، وتعمل على تحقيق قيم الفاعلية والجدية والتشاركية الضرورية من خلال إشراك بل الاستعانة والاستفادة من تدخلات الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والاقتصاديين والحقوقيين … في جدول الأعمال الرسمي.
2/ فتح الإعلام العمومي ،كفضاء عام أمام كل الرؤى والتوجهات المسئولة والصادقة لخلق نقاش عمومي حول القضايا الوطنية الملحة والحيوية والمتعلقة أساسا بقضايا التنمية بجميع جوانبها المختلفة.
3/ توقف النخب الحزبية (موالاة و معارضة ) عن ذر الرماد في عيون الرأي العام الوطني ، والتناحر الزائف حول مفردة تسمى ” الحوار” فقدت معناها ، والبحث بدلا عن ذلك عن الأساليب القمينة باحترام قواعد لعبة سياسية وشفافة تحترم أصول النظام الديمقراطي .
4/ إعادة بعث مؤسسة المعارضة الديمقراطية وتفعيلها لأداء الدور المنوط بها قانونيا وسياسيا.
5/ مأسسة مكافحة الفساد من خلال هيئة أو مجلس مستقل يعنى بالتحقيق في تهم الفساد ويراقب القنوات المعتادة لممارسته ، وتمكينه من الوسائل اللازمة لأداء عمله.
6/ إنشاء مجلس أعلى للشباب يمثل جهة مستقلة تساعد في توجيه القرار الحكومي في العناية والرعاية بهموم هذه الشريحة.
7/ إيجاد الوسائل والآليات الضرورية لفك الارتباط بين المال العام والخاص ، وعدم استخدام المال العام ووسائل الدولة في الاستحقاقات الانتخابية .
8/ تعديل قانون الأحزاب السياسية بحيث يحدد شروطا ديمقراطية أكثر عقلانية فيما يتعلق بحرية إنشاء الأحزاب والتأكيد على قيامها على أساس وطني شامل ( ولو أقتض الأمر فرض نظام كوتا لمختلف الجهات والأعراق داخل المجالس والهيآت القيادية في الحزب )، والتأكيد على احترام قيم جمهورية الدولة والمواطنة والهوية …
إنها مجرد خطوط عريضة لبرنامج إصلاح حقيقي وليست حلا ناجزا ، ويبقى الأمل أن تنضج توجهات حكامنا ونخبنا السياسية على بخار أحداث العالم العربي ويستوعبوا أهمية إشراك الشباب في الشأن العام وتغيير النظرة الاقصائية ، وأهمية الإصلاح الطوعي للدولة والمجتمع وساعتها ( وكفى الله المؤمنين القتال) ، أما أن تظل الأمور كما كانت وكأن وجه الدنيا لم يحدث عليه شيء فتلك مغامرة رسمية تفتح مستقبلنا على المجهول.