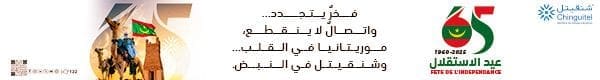أين إذن “الحوار” الشهير، هذه الظاهرة السياسية الصوتية التى تسببت فى السنة الماضية و حتى قبلها، مما زالت الذاكرة تحتفظ به، فى اختلاط الأصوات و تشابك المواقف؟.
لقد تحول من خلال تصدره الإعلام إلى نوع من الأشباح التي تسكن المجتمع السياسي المحلي الضيق و الرأي العام ككل و قد هيًجه و ضخمه “صوت سيده” [سيدهم] الذى يتمثل في وسائل الإعلام الرسمية و المقربة منها، فضلا عن إعلام معين معروف. لقد أجهد النظام القائم نفسه فى حملة واسعة لتأهيل هذا “المنتج” الغريب بخلق جو هو بمثابة “مأوى تحاوري”، تحول بالنسبة إليه إلى نوع من القربان أو الطوطم، و حتى إلى برنامج حكومي (أ لم نشاهد الوزراء يخلون وزاراتهم التي تتخبط فى عديد المعضلات فى هجرة جماعية ليقوموا بالتبشير، فى أقصى مناطق الوطن ؟).
نتذكر الهرج و المرج و الابتهاج المبالغ فيه و الهالة المصطنعة التي أُحيط بها “الحوار” من أفواه و أقلام حشدٍ من باعة “الريئال بوليتيك” المكيِفة مداريا و هواة الخيال السياسي المهرجين و حتى من دعاة المحللين و من قارئات الفنجان .. و الكل يصرخ بصوت واحد : الحوار! الحوار!..
لم يشهد مصطلح تحت سماء هذا المنكب البرزخي مثل هذا الصيت و هذا الحظ الذي حاز المصطلح المتواضع الذى تتقاذفه هفوات كل أشكال الخطاب، المبتذل و المجتر بدون أن يفيد في شيء.
بُعبعٌ و ” تبر أحمر” في ذات الوقت يُلوَح به من أجل تسلية الجمهور أو لتخويف النفس غير الضار أو لطرد أرواح شريرة خفية أو فأل سيء.
منذ المحاولات غير المثمرة الأخيرة من أجل عقد ما يشبه الحوار بين النظام و المعارضة اختفى هذا الأخير فجأة من ما يُتصور أنه حياة سياسية فى البلد تاركا الرأي العام فى حيرة، و فى ذات الوقت، بعض وسائل الإعلام المتخصصة فى التضليل دون مادة تغذى بها نشاطها الدعائي.
تساءل الناس إذا كان “الحوار” سيظهر من جديد بعد هذا الاختفاء الغامض أو يخرج من بياته ليعود للحياة و يفتح آفاقا جديدة للبلد.
و ها هو ذا “الرئيس المؤسس” (سُمي به ربما عن غير قصد – و هي مفارقة مثيرة – من طرف أزلامه الذين ألصقوا به كُنية يطلقها بسخرية فكاهي إذاعة فرنسا الدولية مامان ب”رئيس” جمهورية الغوندوانا الديموقراطية جدا”، النموذج المثالي لجمهوريات الموز الافريقية و غيرها) ها هو – كرد على هذا التساؤل القلق – يخرج من الدولاب “الحوار” الذى كنا نظن أنه قد دفن مؤكدا غير مازح أنه ما زال حيا و ضمن جدول الأعمال.
إن الحوار كمبدأ و كآلية للوقاية من الأزمات و الصراعات و كحل لها على الصعيد الوطني و الدولي، معترف به دوليا و حائز على تراكم واسع من التجربة. إنما في الدول ذات التقاليد الديموقراطية الراسخة ليست السياسة الطبيعية واللعبة الديموقراطية مرهونة بإيقاع أي حوار مؤسسي أو غير مُصنف.
فالحكومة المنتخبة بشفافية تنفذ برنامجها والمعارضة الديموقراطية تصارع سلميا لخلق ظروف التناوب على السلطة، و هما جميعا تتحركان فى نطاق احترام القوانين و وفقا للاستخدام السليم للديموقراطية.
إن مناقشة الأفكار و المناظرات بين البرامج و النشاطات المختلفة الخاصة بكل فريق تدار دائما فى الأسوار و الفضاءات المخصصة لها (البرلمان، الأحزاب السياسية، الإعلام، الأماكن العامة الخ…).
ما ذا يعنى الحوار اليوم فى ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر و فى الوضعية الوطنية المعاشة ؟ ظل النظام يدعى فى كل مناسبة أبوية النداء إلى الحوار، حتى فكرة الحوار نفسها، لكن إذا نظرنا إلى تصرفه على أرض الواقع نلاحظ قدرا كبيرا من عدم الاتساق و من المفارقات، مما يزرع الشك فى نياته و دوافعه الحقيقية.
إنه من العلوم على نطاق واسع عند الرأي العام أن اتفاقيات داكار التي تمت تحت رعاية المجتمع الدولي لم تُفعًل بالشكل المطلوب مما ترك الأزمة الناجمة عن انقلاب 2008تستمر بل تتفاقم. من المعروف كذلك أن نتائج الحوار المنظم فى 2011 بمشاركة جزء من المعارضة بقيت حبرا على ورق ، باستثناء تعديلات ثانوية أدخلت على استحياء فى الدستور.
أخيرا إن جميع المحاولات التى تمت مع منسقيه المعارضة و بعدها “المنتدى الوطني للديموقراطية و الوحدة” لم ينتج عنها شيء رغم الضجيج الذى رافقها في أكثر الأوقات. فى السياق نفسه نلاحظ أن كل نداء للحوار يبتدره النظام يأتي دائما – يا للغرابة – فى الوقت الذى لم يكن منتظرا فيه و فى أغلب الأحيان بعد ما أنجز بصفة أحادية أجندته الخاصة و بتعسف و دون أي اعتبار للقوانين و الأعراف المعمول بها، و بعد أن يجري “التطبيع” و الأمر الواقع ها هو ذا يُخرج من قبعته أرنب “الحوار” راميا به إلى رأي عام منخدع و إلى فاعلين سياسيين شبه فاقدي الذاكرة و أبطال أبديين للعبة الهزلية.
إن غياب المصداقية و عدم الجدية فى التزامات النظام الحالي من أجل حوار وطني جاد تعضدهما تصريحاته المتناقضة التي تنفى وجود أية أزمة فى البلد من جهة و تدعو إلى الحوار مع المعارضة من جهة ثانية. هذه الازدواجية فى الخطاب، هذا الإقدام ثم التردد الدائمان أو على الأصح هذا الانفصام الذى يترجم فى الواقع إخفاء الارتباك و انعدام الاستمرارية و الخواء، مؤشر على نظام يلجأ غرائزيا إلى الهروب إلى الأمام و الخداع كنهج في التسيير. حتى لو أراد التخلص من هذا الطبع فانه يعود بسرعة !
إن فشل النظام أو رفضه الرد كتابيا على اقتراحات المعارضة من أجل إعادة الثقة و بدء حوار بالمعنى الصحيح يبرهن على الحساسية المفرطة و الازدواجية و عدم الجدية تجاه خصومه و تجاه الرأي العام. بسبب هذه الألاعيب أصبح الحوار هاجسا و في الوقت نفسه حدثا جانبيا موسميا، “شيئا” يختفى و يظهر، “شيئا” قابلا لتعدد الاستخدامات و لا يثير إلا التهكم و الإنكار.
يظل من المفيد و من المشروع رغم هذه الحقائق الجلية التساؤل بأكثر جدية من ما سبق عن الدوافع و الأهداف المحتملة للنظام بخصوص عادته المرضية – فى ما يشبه ممارسة طقوس غريبة – فى الدعوة بين الفينة و الأخرى إلى “حوار” ليس مجبرا عليه كما يقول. هل يعود ذلك إلى ضخة مفاجئة من الأدرنالين الديموقراطية أو لِلسْعة حشرة وطنية غامضة أم لوعي شجاع – غير وارد – لواقع البلاد و خطورة المعضلات و التحديات التي تواجهها اليوم و ضرورة إيجاد حلول بإجماع و ذات نجاعة، دون إقصاء. الكل يأتي بتحليله و رؤاه الخاصة، فى غياب عناصر دقيقة، لمحاولة فهم الموقف الملتبس عند النظام الحالي و سبر غور نياته في أمد يطول أو يقصر.
يثار عشوائيا : وقع الأزمة متعددة الجوانب، الفشل الواضح للانتخابات الأخيرة والتي لم تؤد إلى حل أية مشكلة، التذمر المجتمعي الزاحف، تقوية المعارضة، محاولة إلهاءٍ جديدة بهدف صرف الانتباه عن القضايا الساخنة تزامنا مع محاولات زرع الشقاق و الارتباك فى المعسكر المعارض، التحضير على مراحل لشروط تغيير الدستور و إرجاء الاستحقاق المحتمل إلى أقصى ما يمكن للسماح ل”الرئيس المؤسس” بالتقدم إلى مأمورية ثالثة، ما يعزى لهذا الأخير من نية ضمان مخرج آمنٍ لنفسه يجنبه المساءلة و يمكنه من استباق عفو عن الجنايات و الجرائم التي ظل يتهم بها منذ استيلائه على الحكم عن طريق انقلاب عسكري أودى بالبلاد إلى عذابات عدم الاستقرار وسوء التسيير.
لا شك أن الحقيقة هي فى كل ما ذُكر لكنها تكمن بشكل أكثر وضوحا فى سببين اثنين.
السبب الأول الذى يبدو أن أغلبية المراقبين لم ينتبهوا إليه يتجلى فى السعي عمليا إلى شرعنة المأمورية الثانية الجارية التي تُوُصِل إليها فى ظروف غير طبيعية و تَنسِية المجتمع بواسطة الهائه ب”الحوار” للانتخابات التي شابتها مخالفات خطيرة و كانت بلا رهانات بسبب مقاطعة المعارضة لها و كانت نتائجها ال”سوفيتية” تفتقر كلية الى المصداقية.
إن الرفض الشامل لهذه النتائج من طرف المواطنين و المعارضة و عدم الاعتراف بنتائجها المشبوهة قد وصم باللا شرعية و حتى بالإلغاء هذه المأمورية الثانية المنتزعة بشق النفس فى ازدراء بالقانون و العقلانية مما قد يزيد في خطورة الأزمة الموجودة و من الانجراف المتشدد للنظام.
أن السبب الثاني و هو سبب استراتيجي يترجم الإرادة و النية المبيتة – على الرغم من التكذيب المستنكر و نعيق الأوساط الرسمية – لتهيئة شروط مأمورية ثالثة للذي هو قابع راهنا في القصر الرمادي أو على الأقل مأمورية أولى لشَبَهٍ أو ممثل بديل يمكن استخراجه من مستنقع “الأغلبية”.
أحد هذه الشروط يقتضى الحصول على مباركة ل”حوار” منسوج على المقاس و الذى يمَكن من غير كبير مخاطرة و بكل الوسائل و الخداع من استمالة أغلبية القوى السياسية و الاجتماعية فى البلد بهدف أخير هو تعديل الدستور “قانونيا”، “بإجماع” من خلال استفتاء، و إن تعذر فاقتراع ل”لبرلمان” الحالي (أو القادم، ينتخب في ظروف مماثلة).
الهدف الاستراتيجي الحيوي فى جميع هذه المناورات هو الاحتفاظ بالسلطة لأطول فترة بواسطة استكمال هادئ للمأمورية الحالية أو بما هو أفضل عن طريق مأمورية ثالثة خاصة أو بوكالة لطرف ثاني يُصار إلى إقناع الرأي العام الداخلي و الدولي بابتلاع مرارتها من دون مقاومة.
فى كلتا الحالتين يحصل “الإجماع” للمرة الثانية على الجنرال عزيز الذى يكون قد ربح الرهان المزدوج، للاستمرار في ممارسة السلطة – مباشرة أو غير مباشرة – دون أية عراقيل و لضمان سلامة المؤخرة، كما يقال في الخطاب العسكري، عندما تحين ساعة الانسحاب ( أو التقاعد؟). يمكن بسهولة تصور أن الدافع العميق، غير المعلن لهذه المناورات المماطِلة و هذا التربص لخرق الدستور، هو الهوس بالسلطة و بالإفلات من العقاب الذى تُوفَره الطغمة العسكرية – العشائرية – المافيوية المتقادمة التي وضعت البلد فى تراجع دائم.
فقدُ السلطة و إمكانية مواجهة الحساب يوما ما – و بالتأكيد رد المظالم – هذا هو سيناريو الرعب الذى لا يمكن للطغمة تحمله و لا القبول به !
نحن إذن بعيدون عن النفاق و التورع الذى يوحى بأن الدعوة إلى “الحوار” من طرف النظام الحاكم هي من الكرم أو من الروح الديموقراطية ل”رئيسه المؤسس” أو إدراكه للمسؤولية و اتجاه التاريخ.
بطبيعة الحال فعندما يدعى أحد أن لا وجود لأزمة و أنه يتمتع بأغلبية ساحقة فى البرلمان يَسْهل عليه التفاخر بالكرم أو الشفقة تجاه معارضة يعتبرها مصابة بالوهن أو منتهية الصلاحية. لكن ليس في السياسة كما يعرف كل أحد مكان للعواطف و لا الإيثار و لا المشاعر الطيبة تجاه الخصوم، “كل شيء هو غارق فى مياه الحسابات الباردة” التكتيكية الأنانية (بخاصة فيما يتعلق بالأنظمة المعسكرة التي تُبرَر فيها الغاية بالوسيلة بالمعنى الماكيافيلي الأكثر ابتذالا…). إن الصدقة الأكثر عائدا هي التي تبدأ (و تنتهى) بالذات. لقد كان للحكم العسكري الذى يُسيِر حياة البلاد منذ أربعة عقود طوال من خلال تبديل جلده المتكرر و لبوسه المتعدد، كان له الذكاء الأوحد فى استيعاب هذا الدرس. و ليس آخر إفرازاته المتناهية التعسف و النزعة البيْعية الشرائية و الفساد و المحاكاة و النفاق و عدم الكفاءة و سوء التسيير، ليست هي التي تشذ عن هذه القاعدة الذهبية. إن طبيعة هذه الإفرازات و ممارساتها تدل بالتأكيد على تعارضُها الخَلقي مع روح و نص الديموقراطية و مع فضيلة الحوار و التعددية و حسن التسيير.
لقد أثبتت التجربة أن النظام إذا طلب الحوار فيكون ذلك باستخفاف و بنية إفشاله أو معالجته لصالحه. ما يهمه فى الواقع هو شكل الحوار، مسرحية الحوار. إن المعارضة محقة فى اعتبار الحوار خيارا مبدئيا يروم البحث على الدوام عن حل لمشاكل البلد بالطرق السلمية و بخاصة ما يتعلق منها بالوصول إلى السلطة و التناوب عليها و هو من صميم مسؤوليتها التاريخية و مساهمتها فى تنمية و ترسيخ الثقافة الديموقراطية فى البلد. لكن هذا التعلق الضروري بالحوار لا يجب أن يحجب الواقع و يلغي التجربة المرة مع النظام الحالي الذى يبدو أنه يعتبر الحوار مجرد شعار فارغ مثل كل الشعارات الأخرى التى هي صناعته الخاصة و مصيدة و آلة خداع (كما يحب العسكر استخدامها فى تدريباتهم…).
بعبارة أخرى فمن التصور الخاطئ غير المجدي اعتقاد إمكانية الثقة في هذا النظام المبني على الحنث، على الانقلاب الدائم، وعلى الدهاء – لكي لا نقول الخداع – على الرشوة و اللجوء التلقائي إلى القوة الغاشمة ضد الخصوم السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان (المناضلين ضد الاستعباد) و بسطاء المواطنين الذين يقفون سلميا في وجه التعسف و هدر الأموال العمومية و النهب العلني لمقدرات البلد و البطالة و الظروف المأساوية لغالبية السكان (شباب 25 فبراير، “ماني شاري كزوال”).
أبعد من ذلك احتمال قيام النظام بتطبيق أبسط التزامات أي حوار حتى و لو انعقد فى ظروف أحسن ما تكون و بكل ما يمكن تصوره من ضمانات.
لذلك فإن أي حوار و أية نتائج أو تطبيق له هي دائما ترجمة لميزان القوة. فالنظام الحاكم يبذل كل جهده للإبقاء على الوضع الراهن بتعمده الغموض و المواربة من أجل كسب الوقت و خلط الأوراق و إضعاف معنويات خصومه السياسيين.
ينبغي إذن لهؤلاء و لجميع الوطنيين خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديموقراطي و التناوب السلمي على السلطة ليس بالتمني الدائم و ضياع الكثير من الوقت و الطاقة في مراوغات و تحادث لا نهاية له في “حوار” كما يريده النظام لكن بإعطاء الأولوية للنضال و تعبئة جميع القوى السياسية و الاجتماعية و كافة الإرادات الوطنية الطيبة. إن الأمر يتعلق بإحداث قطيعة نهائية مع الأساليب العتيقة بأخذ المبادرة و وضع حد لعادة مجرد ردة الفعل على ما يأتي من النظام.
إن الوسيلة الأكثر فعالية للوصول لهذا الهدف تكمن فى تقوية التنسيق و فى وحدة العمل و التضامن بين كل القوى التي تعمل من أجل التغيير دون إقصاء و دون التركيز على الماضي بعيدا عن الاعتبارات الضيقة ذات الطابع الايديولوجي أو السياسي أو الجمعي المهني لأن خلاص الوطن و مستقبله هما الأساس. بما أن الاتحاد قوة فان ديناميكية التغيير هذه يجب أن تعتمد على وضع سياسة معارضة متسقة و قوية من جل نفي الشرعية عن النظام العسكري – القبلي – المافيوي نفسها و على التنديد المنهجي بطريقته القمعية و بقلة كفاءته و تسييره الكارثي لشؤون الدولة.
إن هذه الاستراتيجية التي هي وحدها تأتى بالنتيجة المتوخاة و التي تعتمد على رافعتين أساسيتين – الضغط الجماعي و العمل السياسي المنسق على جميع الجبهات – لا تنافى المطالبة المستمرة بحوار وطني صادق، حوار هو وحده الطريق الأمثل لتجنب الأسوأ للبلد و لتمكينه من رؤية الضوء فى النفق.
إن النظام الذى يفقد قدرته على مواجهة الأزمة المتعددة الجوانب و الذى هو المسؤول الأول عنها و الذى يصطلي بنار المطالبات الجماعية على المستوى السياسي و الاجتماعي سيُرغَم على التعامل أو يخاطر بالتعرض لزعزعة وضعه و انهياره المحتوم على غرار كل الأنظمة اللا وطنية و المتجاوزة فى الزمن التي كنَسها “الربيع العربي” المستمر في فعله.
فى احتمال معجزة إقامة حوار حقيقي يتعين على المعارضة الاستمرار فى المطالبة بأخذ الشروط المسبقة التي وضعتها كحد أدنى والتي من دونها لا مبرر لهذا الحوار. إن أي موقف آخر سيكون غير مضمون النتيجة و سيسير في اتجاه النظام المهموم ببقائه فوق أي اعتبار آخر و الذى لن يستثني أية وسيلة لتنفيذ أجندته الخفية المذكورة أعلاه و التي بوادرها بدأت تظهر من خلال التسريبات و التصريحات الصادرة عن بعض الوزراء في الأيام الأخيرة.
إن صخرة سيزيف “العزيزية” وعنوانُها الحوار الوهمي ستظل إذن تُدحرج أو سننتظر وعود عرقوب و كلام “الرئيس المؤسس” و تعهداته التي لم و لن يفيَ بها. في كلتا الحالتين لا يمكننا تصور المعارضة في حالة سعادة و لا البلادَ خارجة من الوضعية العبثية التي تدور فيها منذ أن أخذها رهينة النظام العسكري.
حان إذن الوقت لإدراك حقيقة أن “الحوار” الذى يُتغنى بفضائله و حتى بقدسيته عن صدق أو تصنع ليس – ولن يكون في حال حدوثه – الحل السحري.
لقد تحول من خلال تصدره الإعلام إلى نوع من الأشباح التي تسكن المجتمع السياسي المحلي الضيق و الرأي العام ككل و قد هيًجه و ضخمه “صوت سيده” [سيدهم] الذى يتمثل في وسائل الإعلام الرسمية و المقربة منها، فضلا عن إعلام معين معروف. لقد أجهد النظام القائم نفسه فى حملة واسعة لتأهيل هذا “المنتج” الغريب بخلق جو هو بمثابة “مأوى تحاوري”، تحول بالنسبة إليه إلى نوع من القربان أو الطوطم، و حتى إلى برنامج حكومي (أ لم نشاهد الوزراء يخلون وزاراتهم التي تتخبط فى عديد المعضلات فى هجرة جماعية ليقوموا بالتبشير، فى أقصى مناطق الوطن ؟).
نتذكر الهرج و المرج و الابتهاج المبالغ فيه و الهالة المصطنعة التي أُحيط بها “الحوار” من أفواه و أقلام حشدٍ من باعة “الريئال بوليتيك” المكيِفة مداريا و هواة الخيال السياسي المهرجين و حتى من دعاة المحللين و من قارئات الفنجان .. و الكل يصرخ بصوت واحد : الحوار! الحوار!..
لم يشهد مصطلح تحت سماء هذا المنكب البرزخي مثل هذا الصيت و هذا الحظ الذي حاز المصطلح المتواضع الذى تتقاذفه هفوات كل أشكال الخطاب، المبتذل و المجتر بدون أن يفيد في شيء.
بُعبعٌ و ” تبر أحمر” في ذات الوقت يُلوَح به من أجل تسلية الجمهور أو لتخويف النفس غير الضار أو لطرد أرواح شريرة خفية أو فأل سيء.
منذ المحاولات غير المثمرة الأخيرة من أجل عقد ما يشبه الحوار بين النظام و المعارضة اختفى هذا الأخير فجأة من ما يُتصور أنه حياة سياسية فى البلد تاركا الرأي العام فى حيرة، و فى ذات الوقت، بعض وسائل الإعلام المتخصصة فى التضليل دون مادة تغذى بها نشاطها الدعائي.
تساءل الناس إذا كان “الحوار” سيظهر من جديد بعد هذا الاختفاء الغامض أو يخرج من بياته ليعود للحياة و يفتح آفاقا جديدة للبلد.
و ها هو ذا “الرئيس المؤسس” (سُمي به ربما عن غير قصد – و هي مفارقة مثيرة – من طرف أزلامه الذين ألصقوا به كُنية يطلقها بسخرية فكاهي إذاعة فرنسا الدولية مامان ب”رئيس” جمهورية الغوندوانا الديموقراطية جدا”، النموذج المثالي لجمهوريات الموز الافريقية و غيرها) ها هو – كرد على هذا التساؤل القلق – يخرج من الدولاب “الحوار” الذى كنا نظن أنه قد دفن مؤكدا غير مازح أنه ما زال حيا و ضمن جدول الأعمال.
إن الحوار كمبدأ و كآلية للوقاية من الأزمات و الصراعات و كحل لها على الصعيد الوطني و الدولي، معترف به دوليا و حائز على تراكم واسع من التجربة. إنما في الدول ذات التقاليد الديموقراطية الراسخة ليست السياسة الطبيعية واللعبة الديموقراطية مرهونة بإيقاع أي حوار مؤسسي أو غير مُصنف.
فالحكومة المنتخبة بشفافية تنفذ برنامجها والمعارضة الديموقراطية تصارع سلميا لخلق ظروف التناوب على السلطة، و هما جميعا تتحركان فى نطاق احترام القوانين و وفقا للاستخدام السليم للديموقراطية.
إن مناقشة الأفكار و المناظرات بين البرامج و النشاطات المختلفة الخاصة بكل فريق تدار دائما فى الأسوار و الفضاءات المخصصة لها (البرلمان، الأحزاب السياسية، الإعلام، الأماكن العامة الخ…).
ما ذا يعنى الحوار اليوم فى ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر و فى الوضعية الوطنية المعاشة ؟ ظل النظام يدعى فى كل مناسبة أبوية النداء إلى الحوار، حتى فكرة الحوار نفسها، لكن إذا نظرنا إلى تصرفه على أرض الواقع نلاحظ قدرا كبيرا من عدم الاتساق و من المفارقات، مما يزرع الشك فى نياته و دوافعه الحقيقية.
إنه من العلوم على نطاق واسع عند الرأي العام أن اتفاقيات داكار التي تمت تحت رعاية المجتمع الدولي لم تُفعًل بالشكل المطلوب مما ترك الأزمة الناجمة عن انقلاب 2008تستمر بل تتفاقم. من المعروف كذلك أن نتائج الحوار المنظم فى 2011 بمشاركة جزء من المعارضة بقيت حبرا على ورق ، باستثناء تعديلات ثانوية أدخلت على استحياء فى الدستور.
أخيرا إن جميع المحاولات التى تمت مع منسقيه المعارضة و بعدها “المنتدى الوطني للديموقراطية و الوحدة” لم ينتج عنها شيء رغم الضجيج الذى رافقها في أكثر الأوقات. فى السياق نفسه نلاحظ أن كل نداء للحوار يبتدره النظام يأتي دائما – يا للغرابة – فى الوقت الذى لم يكن منتظرا فيه و فى أغلب الأحيان بعد ما أنجز بصفة أحادية أجندته الخاصة و بتعسف و دون أي اعتبار للقوانين و الأعراف المعمول بها، و بعد أن يجري “التطبيع” و الأمر الواقع ها هو ذا يُخرج من قبعته أرنب “الحوار” راميا به إلى رأي عام منخدع و إلى فاعلين سياسيين شبه فاقدي الذاكرة و أبطال أبديين للعبة الهزلية.
إن غياب المصداقية و عدم الجدية فى التزامات النظام الحالي من أجل حوار وطني جاد تعضدهما تصريحاته المتناقضة التي تنفى وجود أية أزمة فى البلد من جهة و تدعو إلى الحوار مع المعارضة من جهة ثانية. هذه الازدواجية فى الخطاب، هذا الإقدام ثم التردد الدائمان أو على الأصح هذا الانفصام الذى يترجم فى الواقع إخفاء الارتباك و انعدام الاستمرارية و الخواء، مؤشر على نظام يلجأ غرائزيا إلى الهروب إلى الأمام و الخداع كنهج في التسيير. حتى لو أراد التخلص من هذا الطبع فانه يعود بسرعة !
إن فشل النظام أو رفضه الرد كتابيا على اقتراحات المعارضة من أجل إعادة الثقة و بدء حوار بالمعنى الصحيح يبرهن على الحساسية المفرطة و الازدواجية و عدم الجدية تجاه خصومه و تجاه الرأي العام. بسبب هذه الألاعيب أصبح الحوار هاجسا و في الوقت نفسه حدثا جانبيا موسميا، “شيئا” يختفى و يظهر، “شيئا” قابلا لتعدد الاستخدامات و لا يثير إلا التهكم و الإنكار.
يظل من المفيد و من المشروع رغم هذه الحقائق الجلية التساؤل بأكثر جدية من ما سبق عن الدوافع و الأهداف المحتملة للنظام بخصوص عادته المرضية – فى ما يشبه ممارسة طقوس غريبة – فى الدعوة بين الفينة و الأخرى إلى “حوار” ليس مجبرا عليه كما يقول. هل يعود ذلك إلى ضخة مفاجئة من الأدرنالين الديموقراطية أو لِلسْعة حشرة وطنية غامضة أم لوعي شجاع – غير وارد – لواقع البلاد و خطورة المعضلات و التحديات التي تواجهها اليوم و ضرورة إيجاد حلول بإجماع و ذات نجاعة، دون إقصاء. الكل يأتي بتحليله و رؤاه الخاصة، فى غياب عناصر دقيقة، لمحاولة فهم الموقف الملتبس عند النظام الحالي و سبر غور نياته في أمد يطول أو يقصر.
يثار عشوائيا : وقع الأزمة متعددة الجوانب، الفشل الواضح للانتخابات الأخيرة والتي لم تؤد إلى حل أية مشكلة، التذمر المجتمعي الزاحف، تقوية المعارضة، محاولة إلهاءٍ جديدة بهدف صرف الانتباه عن القضايا الساخنة تزامنا مع محاولات زرع الشقاق و الارتباك فى المعسكر المعارض، التحضير على مراحل لشروط تغيير الدستور و إرجاء الاستحقاق المحتمل إلى أقصى ما يمكن للسماح ل”الرئيس المؤسس” بالتقدم إلى مأمورية ثالثة، ما يعزى لهذا الأخير من نية ضمان مخرج آمنٍ لنفسه يجنبه المساءلة و يمكنه من استباق عفو عن الجنايات و الجرائم التي ظل يتهم بها منذ استيلائه على الحكم عن طريق انقلاب عسكري أودى بالبلاد إلى عذابات عدم الاستقرار وسوء التسيير.
لا شك أن الحقيقة هي فى كل ما ذُكر لكنها تكمن بشكل أكثر وضوحا فى سببين اثنين.
السبب الأول الذى يبدو أن أغلبية المراقبين لم ينتبهوا إليه يتجلى فى السعي عمليا إلى شرعنة المأمورية الثانية الجارية التي تُوُصِل إليها فى ظروف غير طبيعية و تَنسِية المجتمع بواسطة الهائه ب”الحوار” للانتخابات التي شابتها مخالفات خطيرة و كانت بلا رهانات بسبب مقاطعة المعارضة لها و كانت نتائجها ال”سوفيتية” تفتقر كلية الى المصداقية.
إن الرفض الشامل لهذه النتائج من طرف المواطنين و المعارضة و عدم الاعتراف بنتائجها المشبوهة قد وصم باللا شرعية و حتى بالإلغاء هذه المأمورية الثانية المنتزعة بشق النفس فى ازدراء بالقانون و العقلانية مما قد يزيد في خطورة الأزمة الموجودة و من الانجراف المتشدد للنظام.
أن السبب الثاني و هو سبب استراتيجي يترجم الإرادة و النية المبيتة – على الرغم من التكذيب المستنكر و نعيق الأوساط الرسمية – لتهيئة شروط مأمورية ثالثة للذي هو قابع راهنا في القصر الرمادي أو على الأقل مأمورية أولى لشَبَهٍ أو ممثل بديل يمكن استخراجه من مستنقع “الأغلبية”.
أحد هذه الشروط يقتضى الحصول على مباركة ل”حوار” منسوج على المقاس و الذى يمَكن من غير كبير مخاطرة و بكل الوسائل و الخداع من استمالة أغلبية القوى السياسية و الاجتماعية فى البلد بهدف أخير هو تعديل الدستور “قانونيا”، “بإجماع” من خلال استفتاء، و إن تعذر فاقتراع ل”لبرلمان” الحالي (أو القادم، ينتخب في ظروف مماثلة).
الهدف الاستراتيجي الحيوي فى جميع هذه المناورات هو الاحتفاظ بالسلطة لأطول فترة بواسطة استكمال هادئ للمأمورية الحالية أو بما هو أفضل عن طريق مأمورية ثالثة خاصة أو بوكالة لطرف ثاني يُصار إلى إقناع الرأي العام الداخلي و الدولي بابتلاع مرارتها من دون مقاومة.
فى كلتا الحالتين يحصل “الإجماع” للمرة الثانية على الجنرال عزيز الذى يكون قد ربح الرهان المزدوج، للاستمرار في ممارسة السلطة – مباشرة أو غير مباشرة – دون أية عراقيل و لضمان سلامة المؤخرة، كما يقال في الخطاب العسكري، عندما تحين ساعة الانسحاب ( أو التقاعد؟). يمكن بسهولة تصور أن الدافع العميق، غير المعلن لهذه المناورات المماطِلة و هذا التربص لخرق الدستور، هو الهوس بالسلطة و بالإفلات من العقاب الذى تُوفَره الطغمة العسكرية – العشائرية – المافيوية المتقادمة التي وضعت البلد فى تراجع دائم.
فقدُ السلطة و إمكانية مواجهة الحساب يوما ما – و بالتأكيد رد المظالم – هذا هو سيناريو الرعب الذى لا يمكن للطغمة تحمله و لا القبول به !
نحن إذن بعيدون عن النفاق و التورع الذى يوحى بأن الدعوة إلى “الحوار” من طرف النظام الحاكم هي من الكرم أو من الروح الديموقراطية ل”رئيسه المؤسس” أو إدراكه للمسؤولية و اتجاه التاريخ.
بطبيعة الحال فعندما يدعى أحد أن لا وجود لأزمة و أنه يتمتع بأغلبية ساحقة فى البرلمان يَسْهل عليه التفاخر بالكرم أو الشفقة تجاه معارضة يعتبرها مصابة بالوهن أو منتهية الصلاحية. لكن ليس في السياسة كما يعرف كل أحد مكان للعواطف و لا الإيثار و لا المشاعر الطيبة تجاه الخصوم، “كل شيء هو غارق فى مياه الحسابات الباردة” التكتيكية الأنانية (بخاصة فيما يتعلق بالأنظمة المعسكرة التي تُبرَر فيها الغاية بالوسيلة بالمعنى الماكيافيلي الأكثر ابتذالا…). إن الصدقة الأكثر عائدا هي التي تبدأ (و تنتهى) بالذات. لقد كان للحكم العسكري الذى يُسيِر حياة البلاد منذ أربعة عقود طوال من خلال تبديل جلده المتكرر و لبوسه المتعدد، كان له الذكاء الأوحد فى استيعاب هذا الدرس. و ليس آخر إفرازاته المتناهية التعسف و النزعة البيْعية الشرائية و الفساد و المحاكاة و النفاق و عدم الكفاءة و سوء التسيير، ليست هي التي تشذ عن هذه القاعدة الذهبية. إن طبيعة هذه الإفرازات و ممارساتها تدل بالتأكيد على تعارضُها الخَلقي مع روح و نص الديموقراطية و مع فضيلة الحوار و التعددية و حسن التسيير.
لقد أثبتت التجربة أن النظام إذا طلب الحوار فيكون ذلك باستخفاف و بنية إفشاله أو معالجته لصالحه. ما يهمه فى الواقع هو شكل الحوار، مسرحية الحوار. إن المعارضة محقة فى اعتبار الحوار خيارا مبدئيا يروم البحث على الدوام عن حل لمشاكل البلد بالطرق السلمية و بخاصة ما يتعلق منها بالوصول إلى السلطة و التناوب عليها و هو من صميم مسؤوليتها التاريخية و مساهمتها فى تنمية و ترسيخ الثقافة الديموقراطية فى البلد. لكن هذا التعلق الضروري بالحوار لا يجب أن يحجب الواقع و يلغي التجربة المرة مع النظام الحالي الذى يبدو أنه يعتبر الحوار مجرد شعار فارغ مثل كل الشعارات الأخرى التى هي صناعته الخاصة و مصيدة و آلة خداع (كما يحب العسكر استخدامها فى تدريباتهم…).
بعبارة أخرى فمن التصور الخاطئ غير المجدي اعتقاد إمكانية الثقة في هذا النظام المبني على الحنث، على الانقلاب الدائم، وعلى الدهاء – لكي لا نقول الخداع – على الرشوة و اللجوء التلقائي إلى القوة الغاشمة ضد الخصوم السياسيين و المدافعين عن حقوق الإنسان (المناضلين ضد الاستعباد) و بسطاء المواطنين الذين يقفون سلميا في وجه التعسف و هدر الأموال العمومية و النهب العلني لمقدرات البلد و البطالة و الظروف المأساوية لغالبية السكان (شباب 25 فبراير، “ماني شاري كزوال”).
أبعد من ذلك احتمال قيام النظام بتطبيق أبسط التزامات أي حوار حتى و لو انعقد فى ظروف أحسن ما تكون و بكل ما يمكن تصوره من ضمانات.
لذلك فإن أي حوار و أية نتائج أو تطبيق له هي دائما ترجمة لميزان القوة. فالنظام الحاكم يبذل كل جهده للإبقاء على الوضع الراهن بتعمده الغموض و المواربة من أجل كسب الوقت و خلط الأوراق و إضعاف معنويات خصومه السياسيين.
ينبغي إذن لهؤلاء و لجميع الوطنيين خلق ميزان قوى لصالح التغيير الديموقراطي و التناوب السلمي على السلطة ليس بالتمني الدائم و ضياع الكثير من الوقت و الطاقة في مراوغات و تحادث لا نهاية له في “حوار” كما يريده النظام لكن بإعطاء الأولوية للنضال و تعبئة جميع القوى السياسية و الاجتماعية و كافة الإرادات الوطنية الطيبة. إن الأمر يتعلق بإحداث قطيعة نهائية مع الأساليب العتيقة بأخذ المبادرة و وضع حد لعادة مجرد ردة الفعل على ما يأتي من النظام.
إن الوسيلة الأكثر فعالية للوصول لهذا الهدف تكمن فى تقوية التنسيق و فى وحدة العمل و التضامن بين كل القوى التي تعمل من أجل التغيير دون إقصاء و دون التركيز على الماضي بعيدا عن الاعتبارات الضيقة ذات الطابع الايديولوجي أو السياسي أو الجمعي المهني لأن خلاص الوطن و مستقبله هما الأساس. بما أن الاتحاد قوة فان ديناميكية التغيير هذه يجب أن تعتمد على وضع سياسة معارضة متسقة و قوية من جل نفي الشرعية عن النظام العسكري – القبلي – المافيوي نفسها و على التنديد المنهجي بطريقته القمعية و بقلة كفاءته و تسييره الكارثي لشؤون الدولة.
إن هذه الاستراتيجية التي هي وحدها تأتى بالنتيجة المتوخاة و التي تعتمد على رافعتين أساسيتين – الضغط الجماعي و العمل السياسي المنسق على جميع الجبهات – لا تنافى المطالبة المستمرة بحوار وطني صادق، حوار هو وحده الطريق الأمثل لتجنب الأسوأ للبلد و لتمكينه من رؤية الضوء فى النفق.
إن النظام الذى يفقد قدرته على مواجهة الأزمة المتعددة الجوانب و الذى هو المسؤول الأول عنها و الذى يصطلي بنار المطالبات الجماعية على المستوى السياسي و الاجتماعي سيُرغَم على التعامل أو يخاطر بالتعرض لزعزعة وضعه و انهياره المحتوم على غرار كل الأنظمة اللا وطنية و المتجاوزة فى الزمن التي كنَسها “الربيع العربي” المستمر في فعله.
فى احتمال معجزة إقامة حوار حقيقي يتعين على المعارضة الاستمرار فى المطالبة بأخذ الشروط المسبقة التي وضعتها كحد أدنى والتي من دونها لا مبرر لهذا الحوار. إن أي موقف آخر سيكون غير مضمون النتيجة و سيسير في اتجاه النظام المهموم ببقائه فوق أي اعتبار آخر و الذى لن يستثني أية وسيلة لتنفيذ أجندته الخفية المذكورة أعلاه و التي بوادرها بدأت تظهر من خلال التسريبات و التصريحات الصادرة عن بعض الوزراء في الأيام الأخيرة.
إن صخرة سيزيف “العزيزية” وعنوانُها الحوار الوهمي ستظل إذن تُدحرج أو سننتظر وعود عرقوب و كلام “الرئيس المؤسس” و تعهداته التي لم و لن يفيَ بها. في كلتا الحالتين لا يمكننا تصور المعارضة في حالة سعادة و لا البلادَ خارجة من الوضعية العبثية التي تدور فيها منذ أن أخذها رهينة النظام العسكري.
حان إذن الوقت لإدراك حقيقة أن “الحوار” الذى يُتغنى بفضائله و حتى بقدسيته عن صدق أو تصنع ليس – ولن يكون في حال حدوثه – الحل السحري.