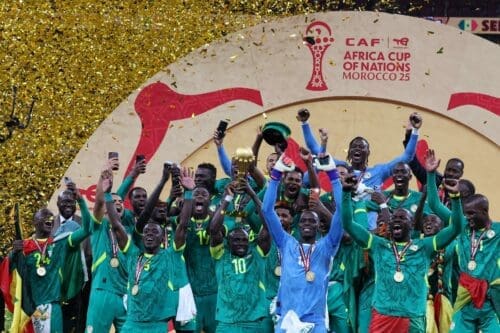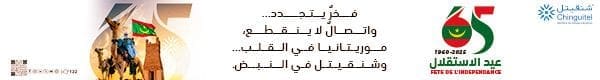هذا النص هو ترجمة لورقة نشرت قبل عشرة أيام٬ بتاريخ 14 من الشهر الجاري٬ باللغة الفرنسية على موقع “بلادي” ويمكن قراءتها أصلها الفرنسي على هذا الرابط.
تلقي هذه الورقة نظرة قانونية محضة على الجدل الدائر حاليا حول لجنة التحقيق البرلمانية والرئيس السابق ومسألة محكمة العدل السامية.
ولكن، وقبل المضي قدما، من المهم إبداء ملاحظتين تمهيديتين أساسيتين: إن الطابع الانتقامي لبعض ما يقام به حالي،٬ وجو الشحن والتجييش، لا يمت بصلة إلى سيادة القانون، ذلك أن أهم ما تتميز به دولة القانون هو ضمان حقوق وكرامة الجميع. ثم إن مؤسسات الجمهورية ملك للجميع وليس من مهامها إشباع الرغبة الانتقامية لهذا الطرف أو ذاك. ثانيا، لقد تم الدوس، خلال العقد الأخير، على دستورنا بما فيه الكفاية، تماما كما تم نهب الممتلكات العامة وامتهان هيبة ووقار مؤسسات الدولة، والنزول بوظيفة رئيس الجمهورية إلى مستوىً ما كان لها أن تنزل إليه. لذا يتوجب على الجميع إبداء حس رفيع بالمسؤولية حتى نتمكن من إنقاذ الأهم: صيانة النظام الدستوري، احترام الشيء العام، هيبة مؤسسات الجمهورية وشرف الخدمة والعمل العموميين.
أما الجدل الحالي، فهو يثير، دستورياًّ، العديد من الأسئلة التي ترتبط كلها بالمسؤولية القانونية للرئيس السابق. وبهذا الخصوص، من المهم التمييز بين المسؤولية السياسية للرئيس السابق والتي بموجبها يُستمع إليه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية أو يقدم لمحكمة العدل السامية، والتي لا تنطبق على الحالة التي بين أيدينا (1)٬ وبين مسؤوليته الجنائية التي ينبغي أن يتحملها، في هذه الحالة، كأي متقاض آخر(2). لا يعني ذلك أن البرلمان لا يمارس أي شكل من أشكال الرقابة السياسية على أعمال رئيس الجمهورية، بل هو يمارسها ولكن تجاه أعضاء الحكومة الذين يتحملون المسؤولية السياسية عن أعمال الرئيس بموجب تقنية التوقيع بالعطف (3). أما مسألة الخيانة العظمى، والتي تظل مفهوما غير معرّف، فهدفها الوحيد هو حماية الوظيفة والمأمورية الرئاسيتين والأثر الوحيد المترتب عليها دستوريا هو عزل الرئيس، ولذا فهي -بحكم التعريف- لا تنطبق على رئيس سابق(4). يبقى أن الأزمة الحالية قد أبرزت بعض الثغرات، وبعض أوجه التناقض والقصور في نظامنا الدستوري التي قد يكون من الضروري تلافيها (5).
(1).لا يحق للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الرئيس السابق ولا يجب على هذا الأخير تلبية دعوتها (أ) وتؤكد ذلك التجارب المقارنة التي أثيرت في النقاش الدستوري الموريتاني الحالي للقول بعكس ذلك (ب). ثم إن التأطير التشريعي للجنة التحقيق في بلادنا جاء عاما واختزاليا وهو ما يقتضي توخي أقصى درجات الحذر عند الممارسة(ج).
أ-لا يحق للجنة التحقيق البرلمانية استدعاء الرئيس السابق للإدلاء بشهادته أمامها بخصوص وقائع جرت أثناء مأموريته الرئاسية. ذلك أن رئيس الجمهورية غير مسؤول أمام البرلمان إلا في حالة الخيانة العظمى. وعدم المسؤولية السياسية لرئيس الدولة أمام البرلمان -عدى حالة الخيانة العظمى- هو أحد المبادئ الدستورية القليلة التي اكتسبت طابعا كونياًّ. ذلك أننا نجده في الأنظمة المقارنة كلها سواء كانت رئاسية أم برلمانية، ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم سلطوية. ونجده في كل هذه الأنظمة سواء اعتمدت تقليد القانون المدني أو الأنجلوسكسوني. وينبني هذا المبدأ على مبدأين دستوريين آخرين هما مبدأ فصل السلطات ومبدأ استمرارية الدولة.
فبموجب الفصل بين السلطات يُحَصَّن رئيس الدولة، حامي الدستور وضامن السير المضطرد للمؤسسات، من المساءلة أمام البرلمان التي قد تتحول إلى شكل من أشكال المضايقة الممنهجة. كما يقتضي مبدأ استمرارية الدولة أن يتمكن شاغل الوظيفة الرئاسية من أداء مهامه بطمأنينة بالٍ وبفعالية وألاّ يخشى أي شكل من أشكال التهديد والترهيب فيما يتعلق بالقيام بمسؤولياته أثناء مأموريته أو بعد انقضائها. والقول بانقضاء هذه الحصانة -الحصانة من المساءلة السياسية أمام البرلمان- بعد انتهاء المأمورية، مجاف لمنطق الدستور على الأقل لسببين: أولا٬ لأنها حصانة وضعت لحماية الوظيفة، أي حصانة للأفعال التي تتأتي أثناء المأمورية الرئاسية وبموجبها. ومن شأن القول بانقضائها مع المأمورية أن يبطل مفعولها والغاية الأصلية منها. ثم إنه يؤدي، بتداعياته المنطقية، إلى القول إن الدستور قد كرّس مبدأ “المسؤولية المؤجلة” لرئيس الجمهورية عن أفعاله الوظيفية.
والحصانة الرئاسية بهذا المعنى هي حصانة وظيفية، وضعت لحماية الوظيفة الرئاسية لا لحماية شاغلها الذي لا يُحصّن من أفعاله إلاّ ما كان منها مندرجاً في إطار القيام بعمله الرسمي. ويدل على ذلك كون الاستثناء الوحيد لهذه الحصانة وُضِعَ لحماية الوظيفة الرئاسية ضد شاغلها نفسه وذلك في حالة الخيانة العظمى.
بناءاً على ما تقدم، يمكن للرئيس السابق أن يزعم أنه لا يحق له التنازل عن حصانة لا يملكها وإنما وضعها الدستور لحماية منصب رئيس الجمهورية. والواقع أن دستورنا يحفظ فضاء كل سلطة بشكل صارم لدرجة أنه لا يعطي رئيس الجمهورية أي حق في التواصل المباشر مع البرلمان (المادة 30 من الدستور).
ب- الممارسة الفرنسية: نظراً لانعدام ممارسة مؤسسية محلية تنير عمل اللجنة الحالية، تم اللجوء إلى ممارسات المؤسسات الفرنسية في النقاش الدستوري الموريتاني الحالي. ولعله من الضروري توضيح نقطتين بخصوص هذه المقارنة: أولاً، إن القانون والفقه القضائي والممارسات المؤسساتية الفرنسية لا تنطبق في بلدنا. إذ يستلزم ذلك أن ينص الدستور صراحة عليه على غرار ما فعله الدستور الجنوب إفريقي بخصوص القوانين الأجنبية مثلاً. ثانيا، وهو ما يجعل المقارنة غير وجيهة بالمرة، إن المقتضيات الدستورية المتعلقة بعلاقة رئيس الجمهورية بالبرلمان تختلف جذريا بين الدستورين. ففي بلادنا يحظر الدستور أي شكل من أشكال التواصل المباشر بين رئيس الجمهورية والبرلمان (م. 30). أما في فرنسا، فلرئيس الجمهورية، منذ 2008، مخاطبة البرلمانيين مباشرة ويجتمعون وجوباً ،لهذا الغرض، في “مؤتمر برلماني” (المادة 18)، ثم إن هذا الخطاب قد يتبع بنقاش يجري في غياب الرئيس. وقد حذّر أهم الفقهاء الدستوريين الفرنسيين، آنذاك، مما ينطوي عليه هذا الإجراء من إمكانية لفتح باب محاسبة الرئيس سياسيا من طرف البرلمان وهو ما يتناقض مع المنطق الأصلي للجمهورية الخامسة. بل إن مشروع الإصلاح الدستوري الحالي الذي تقدم به الرئيس ماكرون ينص على أن يتبع هذا الخطاب بنقاش مباشر بين الرئيس والبرلمانيين، وهو ما من شأنه أن يخلق٬ بكل تأكيد٬ نوعاً من أنواع المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية الفرنسية أمام البرلمان.
ومع ذلك، ورغم أن لجان التحقيق البرلمانية الفرنسية مبوب عليها دستوريا -بينما تجد أساسها القانوني عندنا في قانون نظامي- فإن الممارسة السياسية الفرنسية المتواصلة والثابتة لا تسمح للجان التحقيق البرلمانية باستدعاء رئيس الجمهورية وذلك، على الأقل، منذ أثيرت المسألة لأول مرة عام 1984. بل إن الرئيس ماكرون نفسه الذي يدفع باتجاه تفاعل أكبر بين الرئيس والبرلمانيين أكد نفس المنطق وذلك أثناء أعمال لجان التحقيق في قضية “بن آلا” عام 2018 رغم أنها لا تتعلق بغير التنظيم الإداري لمصالح قصر الأليزيه.
ج. لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية وضرورات “الحذر الاستراتيجي”: نظرا للتأطير القانوني المحدود جدا للجان التحقيق البرلمانية في بلدنا، والذي ينحصر في النظام الداخلي للجمعية الوطنية٬ كان حرياًّ بلجنة التحقيق الحالية اعتماد نوع من الحذر الاستراتيجي من أجل تكريس هذا الشكل من أشكال الرقابة البرلمانية علي أسس صلبة، في موريتانيا. ذلك أن قصور إطارها التشريعي لا يمنح اللجنة نفسها حق التشريع. كما أن عدداً مهما من المبادئ الدستورية والمبادئ العامة التي أقرها فقه المجلس الدستوري الموريتاني تنطبق عليها (للتذكير علي سبيل المثال لا الحصر، يمكن النظر في قراري المجلس الدستوري رقم 001-92 و 007-93 والمتعلقين باللائحة الداخلية للجمعية الوطنية (1) وقانون نظام القضاة).
فمثلا لم يكن صحيحا ولا مناسبا القول إن اللجنة هي مرحلة من مراحل التقاضي بل إن هويتها القانونية هي بالضبط عكس ذلك وتنحصر في طابعها السياسي. وذلك لدرجة أنه يحرم عليها النظر في أي ملف ماثل أمام القضاء كما يتوجب عليها وقف التحقيق في أية مسالة يقرر القضاء بدء النظر فيها (م.124 من النظام الداخلي). كما لم يكن دقيقا، ولا مناسبا، التأكيد أن من حق اللجنة استدعاء أيٍّ كان وأنه يتوجب علي الجميع التعاون معها اذا طلبت ذلك. فمن ناحية، يجب الاعتراف الآن أنه لا يحق للجنة استدعاء رئيس للجمهورية سابقٍ أو حالي، ليس لأنه رفض المثول أمامها ولا لاستحالة استجلابه بالقوة، وإنما لأن حصانته من المساءلة السياسية أمام البرلمان مطلقة وأبدية باستثناء حالة الخيانة العظمي.
كذلك، ورغم أنه للجنة أن تحقق بناءاً علي الوثائق وأن تزور الأمكنة الضرورية للقيام بمهمتها، فيجب الاعتراف، بناءاً علي فقهنا الدستوري، أن أموراً مثل سر الدفاع الوطني وحتى السر الطبي من شأنها أن تكون أعذاراً مقبولة قانوناً لرفض التعاون مع هذه اللجنة. تماما كما أن نفاذها إلى المراسلات يجب أن يتم بشكل متناسب مع ضمان الحقوق الدستورية في سرية المراسلات وفي الحياة الشخصية اللذان لا يمكن المساس بجوهرهما.
كذلك تبقي نقاط كثيرة تحتاج الي الحسم قانونا بخصوص عمل اللجنة: فما زلنا نحتاج إلي توضيح أسباب التنحي بالنسبة لأعضاء اللجنة نفسها، كحالة الأعضاء الذين يحتمل، موضوعياًّ، أن يتم استدعاؤهم كشهود وذلك جرياً على ما أقرّه البرلمان في قانون محكمة العدل السامية على سبيل المثال. وماذا عن حق الشهود أمام اللجنة في الاستعانة بوكيل قانوني أثناء جلسات الاستماع؟ وماذا عن حق الغير في رفع دعاوى بسبب ما قد يعتبر تشهيراً من تصريحات الشهود أمام اللجنة؟ إن توضيح كل ذلك لا يهدف إلي استنساخ الاجراءات القضائية على مسطرة سياسية وإنما إلى ضمان مصداقية هذا الشكل من أشكال الرقابة البرلمانية ومنحه الشرعية السياسية الضرورية.
وعلى العموم٬ فإن عدم مسؤولية الرئيس السابق أمام البرلمان لا تعني أن أفعاله خلوٌ من أي رقابة برلمانية. بل إن الدستور نظم هذه الرقابة بشكل واضح وصريح.
2.المسؤولية السياسية أمام البرلمان عن أعمال رئيس الجمهورية: لما كان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيًّا أمام البرلمان فإن الأخير يمارس رقابته تجاه الحكومة التي تتحمل مسؤولية أفعال الرئيس من خلال تقنية التوقيع بالعطف (المادة 33 من الدستور) التي تستخدم كآلية لنقل المسؤولية السياسية من رئيس الدولة إلى الحكومة. فبتوقيعهم علي قرارات رئيس الجمهورية، يتطوع الوزراء بتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال أمام البرلمان في ظل استحالة مساءلة الرئيس نفسه. وكانت محاكمة السيدة كريستين لاغارد في فرنسا عام 2016، مثلاً، تطبيقا لهذا المبدأ حين تمت إدانتها من طرف محكمة عدل الجمهورية بناءاً على أفعال قامت بها كوزيرة للمالية وتنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية.
ولنشر عرضاً إلى وجود صلاحيات رئاسية غير خاضعة لتقنية التوقيع بالعطف -بل إن توقيع الوزراء “غير ضروري”- ونصت على ذلك المادة 33 من دستورنا في نقل شبه حرفي وتقليد أعمى للمادة 19 من دستور فرنسا وهو نص ابتدعه الجنرال ديغول لأول مرة في تاريخ هذا البلد لتقوية سلطته الشخصية رغم احتجاج فقهاء القانون الدستوري ورجالات الدولة الفرنسيين. ولعل الدستور الإسباني أكثر اتساقاً مع منطق التوقيع بالعطف كآلية لنقل المسؤولية إلى الحكومة حيث يربط بشكل مباشر وصريح بين التوقيع بالعطف ومسؤولية الوزراء في ظل لامسؤولية رئيس الدولة. بل إنه لا يعترف من أفعال هذا الأخير إلاّ بما كان منها موقعاً بالعطف من طرف أعضاء الحكومة الذين تمكن مساءلتهم أمام البرلمان: فمن جهة٬ تنص المادة 56 من دستور هذا البلد على أن: “لا تنتهك حرمة الملك ولا يخضع للمساءلة. ويتم التوقيع بالعطف دائماً على ما يقوم به من أعمال (…)، ولا تنجم عن أعمال الملك غير الموقع عليها بالعطف أية آثار قانونية” ٬ فيما تنص المادة 64 من نفس الدستور على أن “يتحمل مسؤولية أعمال الملك الأشخاص الذين وقعوا عليها بالعطف“.
في حالتنا، لا يثير الموضوع كبير إشكال حيث أن أغلب التصرفات المثارة جرت بتوقيع وتصرف الوزراء المعنيين. وإذا كان منهم من أقروا، أمام لجنة التحقيق البرلمانية، بارتكاب جنح وكان عذرهم الوحيد أن ذلك تمّ بناءاً على تعليمات من رئيس الجمهورية فإن ذلك لا يعفيهم بحال من الأحوال من تحمل المسؤولية السياسية والجنائية. بل إن لسلوكهم ذلك تكييف قانوني واضح وصريح في القوانين الموريتانية كعدم الإبلاغ عن جريمة. وبما أنهم نفّذوا هذه الأوامر فإن مشاركتهم في الجنحة أو الجناية بديهية. وبموجب الدستور تتوجب مساءلتهم عن الجنح والجرائم المعنية أمام القضاء العادي، أو أمام محكمة العدل السامية إذا كيفت هذه الأفعال كجرائم ضد أمن الدولة. وفي هذه الحالة، تطبق المحكمة السامية القوانين المعول بها. إن محاسبة الوزراء عن هذه الأفعال، وشريطة أن يتم تكييفها كجرائم ضد أمن الدولة، ستكون هي المبرر الوحيد لانعقاد الاختصاص لمحكمة العدل السامية. ذلك أن اختصاصها اتجاه الرئيس السابق منعدم وهو فضلا عن ذلك غير مجدٍ في هذه الحالة.
3 الخيانة العظمى ومحكمة العدل السامية: إن القول إن حصانة رئيس الجمهورية من المساءلة أمام البرلمان هي حصانة مطلقة وأبدية عدى حالة الخيانة العظمى يعكس حقيقة أساسية ومبدأً يجري العمل به في كافة النظم المقارنة، وبدون استثناء. وفي موريتانيا، ينص الدستور صراحة، على حصانة الرئيس من كافة أشكال المساءلة السياسية عدى حالة الخيانة العظمي: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.”(المادة 93). غير أنه يبقى ضرورياًّ فهم التبعات القانونية لهذا المبدأ التي تنحصر، في الحالة التي تعنينا هنا، في استحالة استدعاء الرئيس السابق من طرف لجنة تحقيق برلمانية بينما تبقى مسؤوليته الجنائية موضوعاً منفصلاً سنتعرض له في الفقرة الموالية.
أ- نص المادة 93 في سياقه الأصلي: تعتبر هذه المادة نسخة حرفية من الصيغة القديمة للمادة 68 من الدستور الفرنسي لعام 1958. وقد ورثته الجمهورية الخامسة عن سابقاتها الأربع. و مع ذلك، لم يُمكِّن هذا النص -تماماً كما لم يمكن تعديله عام 2007- من تحديد معنى ومفهوم الخيانة العظمي بشكل دقيق ولا من توضيح نظام المسؤولية القضائية لرئيس الجمهورية.
فبناءاً علي هذا النص، مثلاً، والذي نقله دستورنا حرفياًّ، كان من المسلم به في الفقه الفرنسي، إمكانية محاكمة الرئيس الفرنسي أمام القضاء العادي عن الجنح والجرائم التي ارتكبها قبل انتخابه وكذلك عن تلك التي ارتكبها أثناء مأموريته دون أن تكون ذات صلة بممارسة وظائفه. ولذا، بدا طبيعياًّ جداًّ أن يحاكم الرئيس الفرنسي المنتخب، فاليري جيسكار دوستينغ٬ في ديسمبر 1974 في قضية تتعلق بالإعلانات الانتخابية. وكما ورد في حيثيات الحكم، فإنه “لم يتم الطعن في اختصاص المحكمة من طرف فاليري جيسكار دوستينغ رغم وصوله إلى رئاسة الجمهورية، ورغم أن الواقعة تعود إلى شهر ابريل 1974؛ وبناءاً عليه يكون الطرف المدني قد رفع دعواه أمام المحاكم العادية بشكل صحيح“. بديهي كذلك أن موضوع الحصانة لم يثره القاضي من تلقاء نفسه ولا المدعي العام كما يحق له ذلك.
أما التطورات اللاحقة التي قادت إلى نظام حصانة رئيس الجمهورية الفرنسي الحالي -الذي بموجبه لا يكون رئيس الجمهورية قابلا للمتابعة، طيلة مأموريته الرئاسية، على الجنح والجرائم التي اقترفها قبل توليه رئاسة الجمهورية- فلا علاقة له بالنص الذي استنسخه دستورنا وإنما حدثت بموجب فقه القضاء وتعديلات دستورية لاحقة: فقد قادت المشاكل القضائية للرئيس السابق شيراك إلى تأويل قضائي من طرف محكمة النقض الفرنسية في عام 2001 جاء مناقضا لتفسير آخر كان المجلس الدستوري قد أقرّه عام 1999 حول نفس الموضوع. ولذا كان لزاما توحيد فقه القضاء وتوضيح المسؤولية القضائية لرئيس الدولة صلبَ الدستور وهو ما قام به إصلاح 2007 الفرنسي. اذن فالتفسير القضائي لما قبل 2007 لا ينطبق علي موريتانيا كما أن مضمون المادة 68 من الدستور الفرنسي منذو 2007 يختلف جذرياًّ عن النص الذي كنا نقلناه عام1991.
ب- مفهوم الخيانة العظمى: في إطار نفس الإصلاح الدستوري لعام 2007، تخلى الدستور الفرنسي عن مفهوم الخيانة العظمى وأحلّ محله مفهوم “إخلال (رئيس الجمهورية) بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة مأموريته“.
ولم يكن المفهوم الجديد أكثر وضوحاً خصوصاً أنه لم يقم بغير استبدال مفهوم الخيانة العظمى بالعبارات التي كانت تستخدم سابقا لشرحه بما في ذلك من طرف المجلس الدستوري الفرنسي. والواقع أن أهمية مفهوم الخيانة العظمى تكمن بالضبط في غياب أي تعريف محدد وذلك ليشمل كل الفرضيات التي قد تكشف عنها الممارسة في المستقبل.
وفي هذا الإطار تبدو محاولة البرلمانيين الموريتانيين لتعريف الخيانة العظمى بموجب قانون نظامي مفاجِئة لأكثر من سبب: فمن ناحية سيكون البرلمان، بهذا التصرف، قد عرّف مفهوما لم يعرِّفه الدستور ولم يحل إلى قانون نظامي للقيام بذلك، أو بعبارة أخرى فهم يحاولون تعديل الدستور بقانون نظامي وهو ما لن يفوت على المجلس الدستوري الذي ينظر في هذا النص وجوباً. ومن ناحية أخرى، فإنّ البرلمانيين يحرمون أنفسهم، بهذه المبادرة، من سلطة تقديرية مطلقة منحهم إياها الدستور. والحقيقة أن النقاش الحالي في بلدنا يعطي الانطباع أحيانا أن البعض يعلق آمالاً مبالغا فيها على استخدام مفهوم الخيانة العظمى ضد الرئيس الأسبق وكأن عواقب جنائية خطرة تترتب عليه. الواقع أن الخيانة العظمى مفهوم سياسي وليست مفهوما جنائيا. فلا علاقة له مثلاً بجريمة “الخيانة” ولاصلة له بجرم “التخابر مع العدو” اللذين قد تنص عليهما القوانين الجنائية والعسكرية. فالمفهوم سياسي بامتياز وعملي. بمعنى أن الهدف منه هو منح البرلمان سلطة تقديرية مطلقة لحماية الوظيفة الرئاسية من خلال عزل شاغلها إذا تأتى منه ما يستوجب ذلك صراحة وبداهة. ولذا فقد يكون تعريف هذا المفهوم أسلم إذا حصرناه في عناصره الإجرائية ووظيفته الدستورية في حماية المؤسسات وتمكينها من تجاوز أزمة خانقة. فللبرلمان أن يستخدمه ويطبقه على أي سلوك -مهما كان- يعتبره مبررا كافيا لعزل رئيس الجمهورية. ويمكن أن يتعلق هذا السلوك بالحياة الخاصة: لنفترض مثلا أن رئيس الجمهورية قتل زوجته. أغلب الظن أن أحداً لن يأتمن قاتلا على ضمان السير المضطرد للمؤسسات وحماية الدستور. بل إنّ هذا السلوك قد يكمن في الكشف عن ممارسات سابقة على تولي رئاسة الجمهورية وبغض النظر عن صفتها الجنائية وما إذا كانت موضع قانون عفو أو كانت ساقطة بالتقادم. لنفترض، مرة أخرى، أننا اكتشفنا أن رئيساً للجمهورية قام، في سنين خلت، بقتل مدنيين عزل، خارج القانون، وقام بدفنهم، مثلاً، في قرية سوري مالي. مرة أخرى، إن أحدا لن يقول إن هيبة ووقار وظيفة رئاسة الجمهورية مصانان من طرف شاغلها الذي قام بهذه الأفعال وأغلب الظن أن أحداً من مواطني الجمهورية ولا من نوابهم لن يأتمنه على ضمان السير المضطرد للمؤسسات ولا على حماية الدستور. بعبارة أخرى لا يمكن التعرف على الخيانة العظمى “قبْلياًّ” بناءاً على عناصر تعريف مضمونية وضعت مسبقاً، وإنما فقط بشكل “بعدي” وبناءاً على استخدامها إجرائياًّ من طرف الجهة المختصة، أي البرلمان. فلم يكن غريبا ولا عرضا أن كل الدساتير التي اعتمدت هذا المفهوم تجاه رئيس الدولة امتنعت عن تعريفه. وقد طوى النسيان، فجر انقلاب ديسمبر 1851 محاولات دستور 1848 الفرنسي لوضع تعريف مفصل لهذا المفهوم. ولا نتحدث هنا عن الدول التي تنص قوانينها الجنائية على الخيانة العظمى كجريمة جنائية بغض النظر عن مرتكبها (كما هو الحال في ألمانيا أو باكستان).إن التعريف الوحيد للخيانة العظمى الذي يفرض نفسه هو، عن قصد، تعريف دائري ومكرر: يمثل خيانة عظمى كل فعل أقر البرلمان أنه كذلك.
والسؤال الذي يُطرح في الجدل الحالي يتعلق بالضبط بالوظيفة العملية لتهمة الخيانة العظمى. ذلك أن الأثر الوحيد الذي يترتب عليها دستورياًّ هو قرار عزل رئيس الجمهورية وفقط قرار عزل رئيس الجمهورية. وإذا كان الدستور لم يقرَّ أثراً آخر فلا يمكن تصور صلاحية لمحكمة العدل السامية في القيام بأمر آخر. ولعل أفضل وصف لطبيعة هذه المسطرة الإجرائية هو ما أقره المجلس الدستوري الفرنسي في قراره لعام 2014 حول القانون النظامي لمحكمة عدل الجمهورية -نظير محكمتنا السامية: “لا تمثل المحكمة السامية هيئة قضائية مكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية على مخالفات ارتكبها بصفته تلك، وإنما هي جمعية برلمانية ذات صلاحية للنطق بقرار عزله في حالة إخلاله الواضح بواجبات مأموريته“.
إذا كان الأمر كذلك، يبدو بداهة الطابع العبثي لمحاولة محاكمة رئيس سابق من طرف هيئة لا يمكنها القيام بغير عزله من وظيفة لم يعد يشغلها. ثم إن إقرار الخيانة العظمى ليس شرطا مسبقا لتمكين القضاء العادي من مساءلة الرئيس إلاّ أثناء مأموريته. ذلك أن عزل الرئيس يزيح الحماية لتمكين القضاء من مساءلته إن كان من أسباب عزله ما يستوجب ذلك. لأنه، وكما بيناّ، ليس ضرورياًّ أن يكون الفعل المكيف خيانة عظمى جنحة أو جناية بل قد يكون فعلا مشمولا بالعفو أو التقادم غير أن فاعله يعتبر، سياسياًّ، فاقد الأهلية لحماية الدستور وضمان السير المضطرد لمؤسسات الجمهورية. لا يعني ذلك أنه لا يمكن بحال من الأحوال محاسبة رئيس الجمهورية السابق على الأفعال المعزاة إليه حالياًّ. إن ذلك ممكن٬ وأمام القضاء العادي.
(4) من الممكن متابعة الرئيس السابق أمام القضاء العادي بخصوص التهم الجنائية الموجهة إليه حاليا: إن القرائن الخطرة والمتواترة والتي تشير إلى أن الرئيس السابق تصرف، على ما يبدو، في الممتلكات العامة، بمنطق النهب والتملك الشخصي، كافية لتقديمه للمحاكمة أمام القضاء العادي والذي هو قضاؤه الطبيعي في هذه الحالة. والأفعال التي يتهم بها مبوبٌ عليها في مدونات مختلفة من قانوننا الوطني. ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر جنح رشوة الوكلاء العموميين الوطنيين والأجانب، جنح الفساد في الصفقات العمومية، الاختلاس، إخفاء ممتلكات من طرف موظف عمومي أو سرقتها بطريقة أخرى، الرشوة، المتاجرة بالنفوذ، الاستيلاء غير المشروع على المصالح، والثراء غير المشروع. وبإمكان القضاء العادي مباشرة عمله الذي ينبغي أن يجري بطمأنينة بعيدا عن جو التجييش والشحن.
مع ذلك يبقى من الضروري مواجهة التحديات القانونية الممكنة بصراحة وواقعية وهي٬ بالفعل٬ تحديات جدية.
الأعمال الوظيفية والأعمال منبتة الصلة بالوظيفة الرئاسية: يمكن للرئيس السابق الدفع بأن الحصانة التي تغطي أعماله الوظيفية تنسحب على الملفات المثارة حاليا. وصحيح إنها ملفات تصرف فيها بسلطة الدولة ومن وموقع رئاستها وكلف وزراء الجمهورية بتنفيذها. وصحيح كذلك أن النظم المقارنة، خصوصاً تلك التي تعودنا استعارة مفاهيمنا الدستورية منها، تفسر “الأفعال الوظيفية” بشكل واسع جدا. ففي بلد مثل فرنسا انسحبت الحصانة الوظيفية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي على وقائع كيفها القضاء باعتبارها جرائم احتيال بواسطة عصابة منظمة ( قضية تحكيم برنارد تابي)؛ وتبييض أموال بواسطة عصابة منظمة ورشوة موظفين عموميين أجانب (قضية صفقات كازاخستان) واختلاس للأموال العامة (قضية استطلاعات الرأي من طرف الإليزيه). وفي كل هذه الحالات لم يكن هنالك شك في المسؤولية الشخصية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي. ومع ذلك، اعتبرت حصانة أعماله الوظيفية عائقا مقبولاً في وجه متابعته أمام أية جهة كانت، قضائية أم سياسية. لم يثر السيد ساركوزي حصانته بحجة أن محكمة عدل الجمهورية هي وحدها المخولة لمتابعته وإنما بحجة أن حصانته الوظيفية تشمل كل التصرفات التي أتي بها كرئيس وبالتالي فلا تمكن محاسبته إطلاقا. هذا فيما تمت متابعة الوزراء الذين نفذوا تعليماته في هذه الملفات، وكان ذلك حال وزيرته السابقة للشؤون المالية، كريستين لاغارد التي أدينت من طرف محكمة عدل الجمهورية سنة 2016.
بطبيعة الحال، لا تعتبر هذه الممارسة ملزمة في موريتانيا، ثم إن قضاءنا الدستوري لم تتح له الفرصة لتعريف الأعمال الوظيفية وتحديد مضمون ومدى وحدود المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة. ويمكن الجزم إن دفوع المتهمين٬ في حال إطلاق متابعات قضائية في الملفات المثارة حاليا، ستتيح الفرصة للقضاء الدستوري لحسم هذه المسألة.
ثم إن التصرفات التي تعزى حاليا إلى الرئيس السابق لا يمكن أن تدخل٬ بحال من الأحوال٬ في إطار “ممارسة سلطاته”. بل إن استخدام صفته، في هذه الحالة، يعتبر قرينة على إساءة استخدام السلطة وهي جريمة أخرى. فلم يكن من صلاحيات رئيس الجمهورية خرق الدستور والقوانين -مثلاً بخصوص نظام التعارضات- من خلال الانخراط في عالم المال والأعمال مستخدماً مؤسسات الدولة وعلى حساب هذه الأخيرة. إن طعن الرئيس السابق في اختصاص القضاء العادي في هذه الحالة لن يون مقبولاً لأنه يؤدي إلى إنكار للعدالة نظراً لأنّ اختصاص المحكمة السامية لا ينعقد في هذه الحالة. ولعل التجارب المقارنة تعطي أمثلة مهمة على رؤساء دول تجري محاولة متابعتهم٬ حالياًّ٬ أمام القضاء العادي٬ على وقائع رشوة وفساد جرت أثناء ومن خلال توليهم مسؤولياتهم الرسمية رغم تمتعهم دستورياًّ بلامسؤولية مطلقة أوسع نطاقا مما منحه دستورنا لرئيس الجمهورية: رفضت محاولات مساءلة ملك إسبانيا السابق٬ خوان كارلوس أمام البرلمان في شهر مارس الماضي. وحاول القضاء العادي -دون أن يوفق- التحقيق في قضايا رشوة وفساد وتهرب ضريبي يتهم الملك السابق بارتكابها أثناء توليه العرش. وتجري حالياًّ تحقيقات قضائية حول وقائع شبيهة غير أنها لاحقة على تنحي الملك عن العرش.
ومن المناسب التذكير أنه يظل بإمكان القضاء العادي تجنب كل هذا الجدل بخصوص الأعمال الوظيفية والحصانة الرئاسية وذلك من خلال متابعات على أساس وقائع سابقة على تولي الرئيس السابق لوظائفه ولم يشملها التقادم، فمثلا أثار إعلان المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2009 عن ممتلكاتهم أسئلة حقيقية حول مصادر وأسباب ثراء بعضهم. غير أن ذلك يتعلق بتفاصيل استراتيجية قضائية يملك الادعاء العام وحده حق تحديدها.
بناءاً على كل ما سبق، قد يكون مناسبا التوقف للحظة، وضبط ايقاع محاولة محاسبة الرئيس السابق والمتورطين معه والمستفيدين من ذلك. من المهم أن تقوم كل مؤسسة بدورها غير منقوص ولكن دون أن تزيد عليه. للجنة التحقيق أن تقدم تقريرها لإنارة الرأي العام، وسيناقشه البرلمان. ولهذا الأخير أن يخطر وزير العدل -وإن كان ذلك ليس ضروريا لتحريك الدعوى العمومية- إذا كان التقرير يشمل قرائن وشبهات كافية لإطلاق ملاحقات قضائية. ثم إنه للبرلمان، في سياق منفصل، أن يُفعِّل المحكمة السامية لمحاكمة وزراء إذا كانت المعلومات المتوفرة لديه كافية لاتهامهم بالتآمر على أمن الدولة (المادة 93 من الدستور). في نفس الوقت يمكن للقضاء العادي متابعة الرئيس السابق. غير أن كل ذلك يتطلب تنسيقا مركزيا ومفوضاً بسلطة حقيقية لضبط إيقاع عملية تجري على أصعدة ومستويات مختلفة.
إن محاولة معالجة هذا الملف من خلال المسار البرلماني الحالي تنطوي على مخاطر عديدة لعل أبسطها هو انعدام المصداقية وضياع الحقوق: انعدام المصداقية، أولا، في حالة متابعة الرئيس السابق أمام محكمة العدل السامية فيما قد يفسر كخرق للدستور ؛ وضياع للحقوق، ثانيا، لأنه من المؤمل أن تؤدي هذه المسطرة إلى استعادة الشعب الموريتاني لبعض أمواله بما فيها تلك المخفية في الخارج. وسيكون صعبا المطالبة بتطبيق أحكام قضائنا بهذا الخصوص٬ خارج حدودنا٬ إذا كانت مبنية على مسطرة يمكن أن يجد قضاء الدول الأخرى أنها لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.
(5) دروس مستفادة: لقد كشفت الأزمة الحالية عن ثغرات وأوجه قصور وتناقض في نظامنا الدستوري قد يكون ضروريا تعميق التفكير حولها من أجل بلورة الاصلاحات الدستورية الضرورية.
أ – يتساءل البعض -وعن حق- عن مدى ديمقراطية وملاءمة الحصانة والحماية اللتان يتمتع بهما رئيس الجمهورية في نظامنا، وما إذا كان من المقبول أن يكون المسؤول السياسي الأول عن الجمهورية هو “اللامسؤول” الأول سياسيا وقانونيا. وصحيح أن هذه الحصانة قادمة، تاريخيا، من الأنظمة البرلمانية التي لا يمارس فيها رئيس الدولة سلطة حقيقية بل إنها بدأت تنحسر فيها كما يدل على ذلك المثال الإسباني. قد يحلو للبعض استنساخ التعديلات الدستورية الفرنسية الأخيرة والممارسة المؤسساتية قيد التبلور في هذا البلد والتي تعرضنا لها آنفا. غير أن هناك عدداً كبيراً من الاعتبارات التي ينبغي التفكير فيها قبل إعطاء أي جواب نهائي. والأكيد هو أن الدساتير تبقى دائما نتاج تاريخ وثقافة وسياق سياسي محدد ولا يمكن تغيير الواقع المحلي باستنساخ مؤسسات أجنبية. من الضروري، إذن، إعادة التفكير في نظام حصانة وحماية رئيس الجمهورية على ضوء تجربتنا الدستورية والمؤسساتية.
ب- مبرر آخر للقيام بذلك، هو أن الأزمة الحالية كشفت استحالة تطبيق المادة رقم 93 في جميع الأحوال بخصوص رئيس الجمهورية. ذلك أنه بموجب هذا النص فإن الرئيس الذي يقع اتهامه بالخيانة العظمى يواصل عمله طيلة مدة الإجراءات، لأنّ الإتهام لا يعد في دستورنا بمثابة المانع. من جهة، ستكون السلطة الأخلاقية والسياسية لهذا الرئيس متآكلتان وسيصعب عليه -وهو المتهم بالخيانة العظمى- ضمان السير المضطرد لمؤسسات الجمهورية وحماية الدستور. ومن جهة أخرى، وبما أن تهمة الخيانة العظمى لا تُوَجَّهُ في لمحة بصر وإنما هي تأتي دائما تتويجاً لخلاف بين الرئيس والبرلمان، فأغلب الظن أن الرئيس المعني سيقوم بحل البرلمان فور تهديد الأخير باتهامه. ولعل ذلك مبرر إضافي لإعادة النظر في نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في دستورنا.
ج- لا تنص المادة 93 من الدستور صراحة على أن حماية رئيس الجمهورية من المتابعة أثناء مأموريته الرئاسية تشمل كذلك أعماله الخاصة منبتة الصلة بممارسته وظائفه، ولكنها كذلك لا تقول بالعكس. وفي انتظار أن يفسر قضاؤنا الدستوري المسألة أو يحسمها تعديل دستوري جديد، بإمكان المشرع تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية ليفرض، مثلا، على المرشحين لهذا المنصب التزاما مسبقا بتحويل أية عقود عمل أو علاقات قانونية أخرى يمكن تحويلها إلى الغير. ذلك أن رئيسا كالذي غادر السلطة منذ سنة يمكن، كما رأينا، أن تكون له ممتلكات خاصة وعمال يعملون بها. وتجب حماية هؤلاء في وجه عدم إمكانية متابعة الرئيس قضائياًّ أثناء مأموريته في حالة خلاف يتعلق بعقود عملهم.
د- تماماً كما يمكن بتعديل تشريعي على قانون الصفقات العمومية حظر مشاركة عائلة الرئيس وأقاربه إلى الدرجة الرابعة مثلاً في هذه الصفقات.
ه- ويبدو أن مبرر إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية هو مكافحة الرشوة والفساد وهما بالفعل مرضان مستوطنان في بلدنا. غير أنه من المهم، في هذا المجال، أن نكون منسجمين مع هذا المنطق حتى النهاية: إن تشريعاتنا الحالية تصنف أغلب أعمال الرشوة والفساد كجنح وليس كجرائم، ويحصل التقادم بخصوصها بعد خمس سنوات. فلعل مراجعة هذا الإطار التشريعي واحدة من الأولويات بهذا الخصوص.
في الأخير٬ سيكون مهماًّ أن تقوم لجنة التحقيق البرلمانية بعملها بشكل مسؤول بعيدا عن الحسابات الآنية، وأن تضع الأسس الصلبة -كسابقة في هذا المجال- لإرساء هذا الشكل من أشكال الرقابة البرلمانية على قواعد سليمة. بل إن لها أن ترتفع، في تقريرها، عن العناصر الشخصية لترقى إلى مستوى تحليل الوقائع والسياسات لنفهم “كيف كان ذاك ممكنا؟ وكيف تواطأت مجموعة من الأشخاص ونجحت في تنفيذ ما يبدو أنه أكبر عملية نهب يشهدها البلد منذ استقلاله وأخطر تحدٍّ لهيبة وشرف مؤسسات الجمهورية؟”. فكما يقول مؤلف إحدى أوائل مدونات القانون البرلماني في العالم: “لأن لجان التحقيق البرلمانية لجان ينشؤها سياسيون، ويقود أعمالها سياسيون، فهي تنطوي في نفس الوقت على إمكانية لكشف الحقيقة، وإمكانيات عديدة لدفنها، وعلى إمكانية لإنقاذ مذنبين وإمكانية تدنيس شرف أبرياء. وتقوم هذه اللجان، دون أدنى حرج، باستخدام هاتين الوسيلتين”. (André Tardieu, La profession parlementaire, Flammarion, 1937)