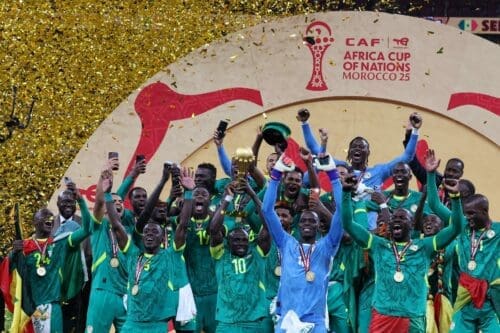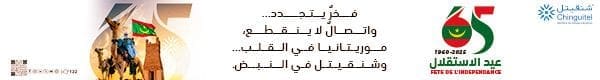لا أحد يستطيع أبدا أن يتطلع، عن قصد أو عن غير قصد، إلى بلوغ ما هو أسمى من ذلك الهدف، إنه هدف يتعدى الطاقة البشرية، ألا وهو: ـ تقويض الخرافات التي تجعل حجابا بين الخالق والمخلوق، وإعادة صلة القرب المتبادل بين العبد وربه، ورد الاعتبار إلى النظرة العقلية لمقام الألوهية المقدس، وسط عالم فوضى الآلهة المشوهة التي اختلقتها أيدي ملة الإشراك.
لا يمكن لإنسان أن يقدم على مشروع يتعدى حدود قوى البشر بأضعف الوسائل، وهو لا يعتمد في تصور مشروعه وإنجازه، إلا على نفسه ورجال لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، يعيشون في منكب من الصحراء. ما أنجز أحد أبدا في هذا العالم ثورة عارمة دائبة، في مدة قياسية كهذه، إذ لم يمض قرنان بعد البعثة حتى أخضع الإسلام، بقوته ودعوته، أقاليم جزيرة العرب الثلاثة، وفتح بعقيدة التوحيد بلاد فارس، وخراسان، وما وراء النهر، والهند الغربية، وأراضي الحبشة، والشام، ومصر، وشمال القارة الأفريقية، ومجموعة من جزر البحر المتوسط، وشبه الجزيرة الإيبيرية، وطرفا من فرنسا القديمة.
فإذا كان سمو المقصد، وضعف الوسائل، ضخامة النتائج، هي السمات الثلاث لعبقرية الرجال، فمن ذا الذي يتجاسر أن يقارن محمدا بأي عظيم من عظماء التاريخ؟
ذلك أن أكثر هؤلاء لم ينجح إلا في تحريك العساكر، أو تبديل القوانين، أو تغيير الممالك؛ وإذا كانوا قد أسسوا شيئا، فلا تذكر لهم سوى صنائع ذات قوة مادية، تتهاوى غالبا قبل أن يموتوا.
أما هو فقد استنفر الجيوش، وجدد الشرائع، وزعزع الدول والشعوب، وحرك ملايين البشر فوق ثلث المعمورة، وزلزل الصوامع والبيع والأرباب والملل والنحل والنظريات والعقائد، وهز الأرواح.
واعتمد على كتاب صار كل حرف منه دستورا، وأسس دولة القيم الروحية فشملت شعوبا من كل الألسنة والألوان، وكتب في قلوب أهلها ـ بحروف لا تقبل الاندثار ـ كراهية عبادة الأصنام المصطنعة، ومحبة الإنابة إلى الواحد الأحد المنزه عن التجسيم.
ثم دفع حماسة أبناء ملته لأخذ الثأر من العابثين بالدين السماوي، فكان فتح ثلث المعمورة على عقيدة التوحيد انتصارا معجزا، ولكنه ليس في الحقيقة معجزة لإنسان، وإنما هو معجزة انتصار العقل.
كلمة التوحيد التي صدع بها ـ أمام معتقدي نظم سلالات الأرباب الأسطورية ـ، كانت شعلتها حينما تنطلق من شفتيه تلهب معابد الأوثان البالية، وتضيء الأنوار على ثلث العالم. وإن سيرة حياته، وتأملاته الفكرية، وجرأته البطولية على تسفيه عبادة آلهة قومه، وشجاعته على مواجهة شرور المشركين، وصبره على آذاهم طوال خمس عشرة سنة في مكة، وتقبله لدور الخارج عن نظام الملأ، واستعداده لمواجهة مصير الضحية بين عشيرته، وهجرته، وعمله الدؤوب على تبليغ رسالته، وجهاده مع عدم تكافؤ القوى مع عدوه، ويقينه بالنصر النهائي، وثباته الخارق للعادة عند المصائب، وحلمه عندما تكون له الغلبة، والتزامه بالقيم الروحية، وعزوفه التام عن الملك، وابتهالاته التي لا تنقطع، ومناجاته لربه، ثم موته، وانتصاره وهو في قبره، ـ إن كل هذا ـ يشهد أن هناك شيئا يسمو على الافتراء، ألا وهو: الإيمان، ذلك الإيمان الذي منحه (عليه الصلاة والسلام) قوة تصحيح العقيدة، تلك العقيدة التي تستند إلى أمرين هما: التوحيد، ونفي التجسيم: أحدهما يثبت وجود البارئ، والثاني يثبت أن ليس كمثله شيء. وأولهما يحطم الآلهة المختلقة بقوة السلاح، والثاني يبنى القيم الروحية بقوة الكلمة.
إنه الحكيم، خطيب جوامع الكلم، الداعي إلى الله بإذنه، سراج التشريع.
إنه المجاهد، فاتح مغلق أبواب الفكر، باني صرح عقيدة قوامها العقل، وطريق عبادة مجردة من الصور والأشكال، مؤسس عشرين دولة ثابتة على الأرض، ودعائم دولة روحية فرعها في السماء، هذا هو محمد، فبكل المقاييس التي نزن بها عظمة الإنسان، فمن ذا الذي يكون أعظم منه؟