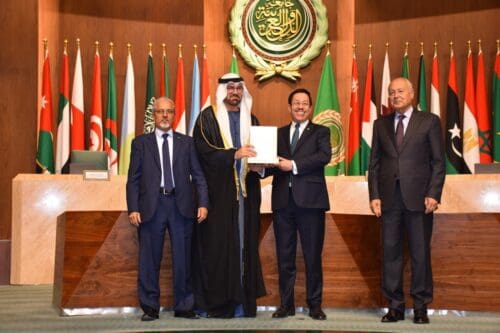نالت موريتانيا استقلالها من المستعمر الفرنسي سنة 1960، في تلك السنة، و تحديدا صبيحة يوم الثامن و العشرين من نوفمبر، رفرف العلم الوطني، بلونيه الزاهيين، الأخضر و الأصفر، المحببين بطبيعتهما لدى النفس البشرية (أليسا لوني الخضرة و الذهب؟)، رفرف خفاقا فوق المباني الحكومية (عفوا المخيم الحكومي بالأحرى! نعم المخيم! فقد احتفلت موريتانيا بنيلها للاستقلال في خيمة، حيث لم تكن هناك بعد مباني حكومية في العاصمة المزعوم إنشاؤها آنذاك!).
منذ ذلك الوقت وعلمنا الوطني يرفرف فوق ما شاء الله من الخيام و المباني الحكومية و يرفع من طرف السلطات العمومية ـ لا من قبل الشعب ـ في بعض المناسبات المختلفة هنا وهناك: زيارة رئيس أجنبي للبلاد، ذكرى عيد الاستقلال…، دون أن يكون لمعظم أفراد الشعب العادي أدنى فكرة عن معناه أو لأي شيء يرمز، فالعلم علم الدولة و علم السلطات الرسمية لا علمنا نحن الأفراد العاديين، تماما مثله مثل النشيد الوطني.
استمر الحال على هذا المنوال فترة من الزمن كاد خلالها العلم الوطني يمحى من الذاكرة الجمعية لمن كانوا يهتمون به من أهل الوطن على قلتهم لولا تلك المناسبات آنفة الذكر و التي لم تكن تعني للكثير منا الكثير!.
غير أنه و منذ فترة قصيرة (ابتداء من سنة 2009) بدا العلم الوطني و كأنه يتسلل إلى قلوب و وجدان المواطنين الموريتانيين، فلأول مرة يعي السواد الأعظم من الشعب الموريتاني أن له علما و أن هذا العلم يستحق أن يرفعه كل شخص ينتمي لهذا البلد مهما كانت منزلته الاجتماعية أو طبقته أو عرقه أو وظيفته أو اتجاهه السياسي. هكذا بدأنا نرى أن بعض الأشخاص أصبحوا يحرصون على الظهور متقلدين قطعا من القماش تحمل العلم الوطني أو رافعين أعلما صغيرة أو حاملين أشياء تدل عليه: رؤساء أحزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني، صحافيو التلفزة الوطنية أثناء تقديم البرامج و النشرات الإخبارية… أما بالناسبة للمواطنين البسطاء فقد كانت هذه الظاهرة الجديدة ـ ظاهرة الاهتمام بالعلم الوطني ـ أكثر وضوحا و انتشارا. فما أن تحين ذكرى الاستقلال في هذه الأيام حتى يبادر المواطنون إلى اقتناء الأعلام الوطنية ليرفعوها فوق سياراتهم و يعلقونها بداخلها، يستوي في ذلك السيارات الخصوصية و سيارات الأجرة و الباصات و الشاحنات وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب و تلك المخصصة لنقل مياه الصرف الصحي ( حاشى القراء الكرام و حاشى العلم الوطني طبعا!) . و لم يتخلف أصحاب العربات التي تجرها الدواب المعروفة محليا باسم ” شاريتات” عن الركب ، فرفعوا هم أيضا الأعلام على عرباتهم و فوق ظهور دوابهم. حتى باعة بطاقات التزويد الجالسين على قارعة الطريق شاركوا بدورهم و بحماسة في موجة الاعتزاز المتنامي بالعلم الوطني هذه. و قد استتبع ذلك أن أصبح هناك تجارة قائمة بذاتها تبلغ ذروة رواجها ما بين بداية شهر نوفمبر و منتصف شهر ديسمبر من كل عام. ففي هذه الفترة تنشط ورشات الخط و الإشهار لطباعة الأعلام الوطنية بجميع أحجامها و أشكالها، كما تكتظ ملتقيات الطرق، خاصة في العاصمة، بالباعة المتجولين وهم يعرضون الأعلام والكثير من المنتجات الأخرى التي تحمل العلم الوطني، كالقمصان و القبعات و جمًاعات المفاتيح و غيرها، بأسعار في متناول الجميع. و قد زاد من الاهتمام بالعلم الوطني هذه السنة إعادة الروح إلى احتفال طال به البيات أو النسيان، و نعني به عيد إنشاء الجيش الوطني ( مفخرة الوطن و المواطن)، وقد أعيد الاحتفال به هذه السنة لأول مرة بعد أكثر من نصف قرن من السبات.
و مع كل هذا الاهتمام من طرف الشعب الموريتاني بعلم بلاده، فإننا نلاحظ أن البعض ما زال يستنكف من رفع العلم الوطني بيده أو على سيارته و لو في المناسبات و التظاهرات الوطنية و يتحرج أكثر من رفع صوته بالنشيد الوطني، خاصة علية القوم. فرفع العلم و إنشاد النشيد الوطني، بالنسبة لغالبية أفراد الطبقات العليا في مجتمعنا أو من يحسبون أنفسهم كذالك، مسألة شعبية ولا تتماشى مع ” الأتيكيت” و الذوق الرفيع و من ثم لا تليق بشخص محترم!
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه يتلخص فيما يلي: ما هو يا ترى سبب صحوة الموريتانيين فيما يتعلق بالاهتمام بعلمهم الوطني بعد مرور أكثر من خمسة عقود على استقلال بلادهم و إنشاء علمهم؟
قد يعود السبب إلى أن مادة التربية المدنية أصبحت مقررة في المناهج الدراسية الوطنية منذ بعض الوقت، خاصة في المراحل الابتدائية و الإعدادية، و أن بعض المدارس أصبحت تفرض( قدر المستطاع ) على التلاميذ الوقوف لتحية العلم و هو يرفع قبل الدخول صباحا. ربما. و إذا كان الأمر كذالك فمعناه أن صغارنا بدؤوا يعلموننا حب الوطن و الاعتزاز برموزه بدل أن نعلمهم نحن (انقلبت الآية إذاً ! ). لا غرابة في ذلك، إذ أن غالبية المواطنين من ذوي الثلاثين سنة من العمر فما فوق قليلي الحظ ـ مع الأسف ـ من الثقافة والوعي المدنيين، بينما نجد الأطفال دون التاسعة من العمر يعرفون معنى ألوان العلم و معنى كونه يحمل هلالاً ونجمة، كما أنهم يعرفون كم عدد غرف البرلمان، و تجدهم يتحدثون عن السلطات المركزية و الجهوية و المحلية و يعرفون الفرق بينها. فهل نحن ـ متوسطي و كبار السن ـ نعرف كل ذلك اليوم؟
كما يمكن أن يعود السبب إلى كون رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز سن، منذ مجيئه إلى السلطة، عادة التلويح بالعلم الوطني كلما أراد أن يعطي انطلاقة مشروع ما، و بالأخص تلك المشاريع التي تلامس مباشرة حياة المواطن العادي، كشق الطرقات و تعبيدها و تدشين المستشفيات و تزويدها بالمعدات و استصلاح القطع الأرضية و توزيعها على المواطنين… لا غرابة في ذلك أيضا، فالرعية، من قديم الأزمان، على قلب الأمير.( أرجو أن لا يتسبب ذلك في عزوف معارضي ولد عبد العزيز مستقبلا عن علمهم الوطني أو زهدهم فيه، فليلوحوا هم أيضا بالعلم و يرفعوه عاليا، فهو علم الجميع و ليس حكرا على ولد عبد العزيز أو ماركة مسجلة باسمه).
بالإضافة إلى السببين المحتملين سابقي الذكر و أسباب أخرى قد تكون أكثر أهمية و أكثر تعددا غابت عن ذهننا، فإن سبب اكتشاف الموريتانيين لعلمهم الوطني من جديد قد يعود بكل بساطة إلى انتشار و سائل الإعلام بشتى أصنافها على امتداد التراب الوطني و كونها في متناول الجميع. أصبح الموريتاني يرى عبر وسائل الإعلام المختلفة مواطني الدول الأخرى و هم يحملون أعلامهم بكل فخر و اعتزاز، خصوصا أثناء ثورات الربيع العربي أو لنقل في الحقيقة ” ثورات الفصول الأربعة العربية“.
أيا كان السبب من وراء انبعاث تعلق الموريتانيين بوطنهم و برموزه، فإن هذا التعلق أصبح حقيقة واقعية نرجو أن تترسخ و تتعمق و أن يزداد إيمان الجميع بدولتهم و مؤسساتها وأن ينصاعوا طواعية أكثر فأكثر لما يصدر عنها من قوانين.
و كل استقلال و الوطن و مواطنيه وعلمهم بخير.