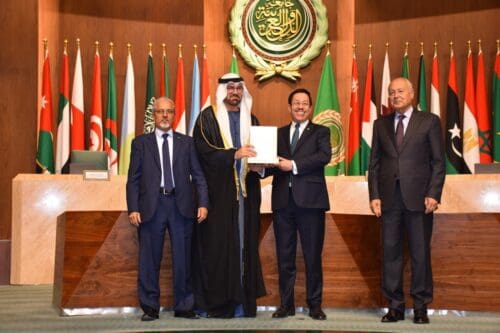باحث بمجال العلوم السياسية والدستورية
“تفقهوا قبل أن تسودوا”
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
“وبعد أن تسودوا”
أبو عبدالله البخاري
في البداية إن التساؤل عن تعريف الفقه والسياسة والفقيه والسياسي ، الغاية منه استكشاف العلاقة انسجاما أو تضادا بين الحقلين، ولا سيما على مستوي الوظائف والأهداف – وسنغفل هنا وبشكل إجرائي مؤقت – مناقشة هذا الموضوع للإشارة إليه لماما في خلاصات هذا المقال ونتائجه ، ولكن لا بد من الإشارة ابتداءا إلى أن المعاني الإصطلاحية والعامة للحقلين تشير رغم تمايز الموضوعات بين العلمين ،إلى وجود نوع من العلاقة بل قيام مفاهيم ومساحات مشتركة ومتداخلة بينهما، فإذا كان الفقيه يشتغل على العلوم الشرعية ضمن حقل الفقه الذي يتعلق اصطلاحا بمعرفة أحكام الشريعة وتنزيلها على الواقع بمختلف جوانبه، فإن الفقه بهذا العموم والشمول وبهذه المعاني يقارب أو يشتغل لحساب بناء رؤية عامة للحياة توجيها وترشيدا، وكذا السياسة التي هي فكر وعمل يروم بناء رؤية تمثل موقفا للبناء ،فهي نسق من الأفكار(النظريات و الرؤى) والجهود موجه للحياة العامة إصلاحا وتهذيبا كالفقه تماما ، فصيرورة الإنسان والوقائع هي مادة الفقه والسياسة على حد سواء،بهذا نكتشف تلك العلاقة المتقاطعة والمتداخلة بين السياسة والفقه وبين عمل ووظيفة السياسي والفقيه.
أما بخصوص تجربتنا السياسية تاريخيا، فقد عرفنا كمسلمين أنماطا متعددة من الحكم وممارسات متنوعة للسلطة لكنها متداخلة ومتمايزة في آن رغم التحقيب التاريخي لها ،فضلا عن تنوع وتعدد القيم التي شكلت مضمونا لتلك الأنماط والممارسات .ويمكننا وبشكل منهجي ولرصد أنواع الحاكمية في الممارسة التاريخية أن نلجأ إلى تصنيف أطوارها منذ بروز الدعوة الإسلامية إلى اليوم بأربعة أطوار من الحكم السياسي – على سبيل الإجمال – مع ملاحظة التداخل في القيم والأشكال بالرغم من الفروق الجوهرية والأداتية في تدبير الحكم(السلطة).
المرحلة الأولى : هي مرحلة ظهور الدعوة وانتشار الإسلام، ومن الضروري منهجيا أن نميز فيها بين طورين الأول : طور تكون الجماعة الإسلامية “مرحلة مكة” وقد بدأت فيها بوادر تشكل مجتمع جديد ومختلف عن المجتمع المكي التقليدي الكبير،مع بروز مرجعية خاصة تعلن عقيدة دينية جوهرها السياسي يحمل رسالة شديدة الوقع والتأثير على النمط الاجتماعي والسياسي وبالتالي على النسق السلطوي القائم .وهو ما بدا واضحا لكبراء وسدنة نظام المجتمع المكي التقليدي والوثني.، فلم تكن كلمة التوحيد التي تشكل على أساسها ومتطلباتها ذلك المجتمع المسلم الأول الصغير في نظرهم – وهم على حق في ذلك – سوى بداية تقويض أركان نظامهم السلطوي ومكانيزماته الخفية بشكل لا رجعة منه.،فقيم الدعوة الجديدة تقيم المجتمع ومؤسسة السلطة فيه على هيراركية جديدة تماما ،فلن يكون الحسب والنسب والنشب هذه المرة هو الذي يحدد قيمة الفرد في المجتمع الجديد ،وإنما إنخراطه في الدين الجديد ودرجة معرفته و استعابه له، وعمله في خدمته ،واجتهاده هو الذي سيحدد دوره وموقعه في النسيجين السياسي والاجتماعي –يا له من تطور مذهل حقا – فقيمة التقوى بمعني الإسلام والامتثال لله والعمل له وبه هي المحدد الجديد .وهي قيمة ستقضي على فكرة اللامساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة لعقود وقرون قبل الإسلام وستعود بعد عقود قليلة منه للأسف – وهو مدعاة التفكر والتأمل – المهم في هذه المرحلة أن قيما جديدة وعديدة ستنبت مع بداية الدعوة الإسلامية وستسقى بالعرق والدم يوميا لتشكل بذور نسق سياسي جديد لا عهد للعرب أو العالم به في تلك العصور التاريخية ، وهو ما سيبرز خلال الطور الثاني من هذه المرحلة – أي ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة – وتشكل نواة الدولة الإسلامية .ونطلق هنا وصف الدولة على هذا البنيان لقيام العناصر القانونية(الدستورية) والسياسية والسيادية للمدينة الجديدة .وغني عن القول أن هذا الطور من الحكم هو طور “حكم النبوة” حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس ويدعوهم للحياة ويسوسهم بالوحي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.فكان النبي (ص) نبيا داعية مبلغا وقائدا عظيما مخططا وإنسانا رحيما مربيا، وكانت الدعوة والقيادة والتربية أدوار قامت على أمر الوحي وعلى ضوء بصيرة النبوة.،وهذا الطور بلا شك الدولة فيه دينية لقيادتها من نبي يوحى إليه ،وقيامها على قيم دينية ولكنها إنسانية أيضا. ومن الواضح أن العلاقة بين الحاكم والمحكومين (النبي والأتباع) في هذا الطور كانت قائمة على مزيج من النداء والتشاور،النداء في المسائل الدينية استسلاما من الرعية للوحي ( أطيعوا الله ورسوله) ، وعلى التشاور في القضايا والأمور الدنيوية (أنتم أعلم بأمور دنياكم …) (أهو الوحي أم الرأي ؟…) وإذا كانت أقوال وأفعال وتقريرات النبي (ص) تعتبر تشريعا فنستفيد بأن الشورى والاستشارة تمثل قيمة سياسية وشرعية لا غنى عنها في إدارة شؤون الحكم والسياسة .،وهو ملمح هام رغم تسليم أغلب الكتاب به إلا أنه يمثل سبقا للتجربة السياسية الإسلامية حتى على بعض الأنظمة السياسية المعاصرة والتي لا تزال تتسم بالطابع التقليدي واللاعقلاني – خصوصا إذا أستلهمنا المنهج الفيبري في تحليل و دراسة براديقم السيطرة السياسية – وهو ما نستنتج منه كيف كان الإسلام قوة تغيير وقيادة إلى الأفضل وإلى المستقبل ،وهو سر كامن في الإسلام أن يظل قوة تجديد أبدا فبذور وقوة الحياة فيه متدفقة بشكل لا مثيل له.
أما المرحلة الثانية: فهي مرحلة الحكام العلماء “الخلافة الراشدة” ومن أبرز سمات هذه المرحلة التاريخية انقطاع الوحي لتمثل بداية الاختبار والامتحان للمسلم الجديد ،و مدى قدرته على الاستمرار وتأسيس تجربته السياسية على ضوء التنشئة الدينية والسياسية التي دامت 23 عاما ،وبتأمل منصف ودقيق كانت الفترة الراشدية فترة رسوخ وازدهار الدولة الجديدة وبداية دخولها عصر الإمبراطورية الذهبي .وهنا عرف النظام الإسلامي كيف يطور منهجه ورؤيته تمشيا مع الخبرة اليومية ،فكان عهد التوسع ووضع أسس الإدارة بما تعنيه من تدبير وتخطيط وتنظيم ،وتفتقت عقول القادة والصحابة عن أفكار رائدة في سبيل قيام الدولة سواء في تدبير الجيوش أو الأموال أو السكان …،فالسيرة السياسية للخلفاء الراشدين الأربعة تنبئنا بلا مواربة عن علو كعبهم كعلماء وفقهاء راسخين في قيادة الدولة والمجتمع .، فالدولة الفتية عرفت كيف تصوغ رؤيتها وكيف ترسخ تقاليدها في المجالات العسكرية والسياسية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية …فكانوا بحق “الأقلية الجذابة” حسب “توينبي” . وكانت المرجعية المعتمدة لإدارة الشأن العام مزيجا من الأحكام (القرآن والسنة) والتذرع بآليات التشاور والخبرة والحكمة والرأي والتبصر والموعظة.،فكان النص الديني ومختلف الوسائل المستحدثة عن طريق التجربة والتراكم تشكل خلفية ممارسة الفعل السياسي بمعناه الواسع.،وأظن أن هذه المرحلة تشهد للفقهاء لا عليهم ، بل إن الفقه هنا ارتقى بالأداء والمنطق السياسيين وبقواعد اللعبة السياسية فيما عدا فترات محدودة بالنسبة لعمر التجربة.
أما المرحلة الثالثة : فقد كان فيها الحكم من نوع آخر .،إذ تطورت التجربة السياسية في استلام الحكم والتداول عليه إلى التوارث (الملك العضوض). وهي مرحلة تحول تفتح جدلا فكريا بامتياز عند الباحثين حين يتساءلون :هل الإسلام كمرجعية نصية يحبذ شكلا معينا من أشكال الحكم أم لا؟ ولماذا؟ وفي تقديري الخاص أن عدم نص الإسلام على نموذج أو شكل معين للحكم والسلطة هو إعجاز لمن أتعظ بالتاريخ!فالإسلام يرسي مبادئ عامة في الحياة عموما وفي السياسة خصوصا دون أن يفرض نموذجا محددا.،فقد أقتضت حكمة الله المحيطة بالخلق أن نرى كل أشكال الحكم في المجتمع الإسلامي – مصداق حديث حذيفة بن اليمان عن النبي (ص) – فرأينا “النبوة” وهي فترة الاقتداء والألق وهي الأساس والمثال، ورأينا “الفترة الراشدة” حيث سيادة مفاهيم التشاور ومرونة النموذج من خلال تعدد صيغ تسلم القيادة،مع الترفع عن الحظوظ الشخصية في العملية السياسية.، وهو درس عميق في السياسة الأخلاقية ، ورأينا “الملك” ورأينا “التغلب” وهي أطوار- رغم القتامة التي أحاطت ببعض جوانب التجربة – ستساعد على شحذ الرؤية السياسية للأمة وبناء الخبرة والتراكم الضروريين،مما يجعلها تستعد للخلافة على منهاج النبوة .فالإسلام حين يرسي المبادئ العامة ،يظل مرنا وتواقا لإعطاء الإرادة الإنسانية حظها وحريتها في تطوير النماذج .بهذا المعنى حين يبيح الإسلام ويحترم التجربة الإنسانية التي ستتطور فيها الأفكار والأحداث.،فإنه يعطي للإرادة والحرية عند الإنسان معنى آخر أكثر تجاوزا وملائمة وعمقا.، فما يصلح لمجتمع أو بقعة قد لا يصلح لأخرى …المهم أن شرط رضا الناس عن قيام السلطة مبدأ إسلامي ، وأن حكم الناس بالشريعة والمصالح مبدأ، وأن العدل مبدأ ، وأن المساواة مبدأ.، ولكن شكل الحكم أو نموذج السلطة خاضع للإتفاق، وهو ما سيساهم في إنضاج التجربة السياسية والسلطوية داخل الأمة المسلمة .، وهذه المرحلة الثالثة من الحكم عند المسلمين تاريخيا هي مرحلة مختلطة من ناحية القيم اللاحمة للنظام السياسي وتمثل طورا أتسعت فيه الدولة وتنوعت فيه مكوناتها السكانية وتوسعت فيه مهام الحكام ، مما جعل التغير يصيب المهام التقليدية للحاكم وهو ما أنعكس على الإدارة والسلطة ،فتمايزت الفضاءات واتخذ الحجاب إشارة رمزية إلى تمايز حيز “السلطة ” عن “الرعية” .،وتخلى الحاكم طواعية عن جزء من سلطته القضائية إلى قاض مستقل في نظره وحكمه عن السلطة الزمنية للحاكم – ولو نظريا في أغلب الأحايين – وهو من جهة سبق للتجربة السياسية الإسلامية على المستوي العام في محاولة الفصل بين السلط كما سنراها في العصر الأوروبي الحديث عند مونتسكيو. وإن كان منطق الفصل مختلفا. ، ففي الوقت الذي يلمح منطق الفصل عند منتسكيو إلى سلطة توقف أخرى ،فإن منطق الفصل في التجربة السياسية الإسلامية تاريخيا هو منطق تعاوني في نظري –(رغم الاحترام الخاص الذي نظر به بعض الخلفاء إلى أحكام القضاء)- وهو ما يحد من فكرة الصراع بين مكونات و أجنحة السلطة داخل الدولة والذي يغري بظهور النزعات الشخصية .، وهو ما أصبح يعالجه الفكر القانوني الديمقراطي الغربي الحديث بفكرة “هيمنة السلطة التنفيذية ” و ” الأغلبية ” و بفكرة “التوافق” …،ومن حسنات هذه الآلية وهذا التطور القدرة على تحديد المسؤوليات داخل النظام . وأخيرا لا يصح النظر إلى ذلك الفصل بين السلطة التنفيذية والقضاء بأنه فصل كامل ولا أنه نتيجة الجهل بالدين والفقه لدى الحاكم – كما يصور البعض – وإنما التطورات الموضوعية ( توسع الرقعة وتنوع وتزايد الأقضية واتساع مهام الحكام…)هي محرضات لمثل هذا التطور. ورغم الأهمية الخاصة التي شهدتها هذه التجربة من الحكم ،فإن الحكام فيها لم يكونوا على سوية واحدة من المعرفة والإنجاز،فمنذ العهد الأموي حتى نهاية الدولة العثمانية مرورا بالدولة العباسية ،حكم السلاطين الجهلة الضعفاء وساد الخلفاء الحكماء والفاتحون .ونضرب مثلا معلوما بالحاكم الصالح الفقيه عمر بن عبد العزيز الذي رد المظالم وأقام القسط وعدل في الأرزاق ونماها (المال العام) وقوى شوكة الدولة ،وقل ذات القول عن محمد الفاتح نعم الأمير .،فما سياسة الدول بأمر زائد عن تحقيق قيم العدل والإزدهار والرخاء والشوكة (القوة والهيبة ).
أما المرحلة الرابعة : مرحلة الغثائية (السقوط) فقد نشأت لتضامن وتضافر عديد من العوامل منها ما هو تاريخي وسياسي ، وأبرز تلك العوامل دخول أوروبا عصر الازدهار وخروجها من عصرها الوسيط المظلم ، وتراجع النهضة في البلاد الإسلامية ، وتتويج هذا الوضع المستجد بسقوط الخلافة كمظلة سياسية ورمزية ،ونشوء واستيلاء الحركة الكولونيالية على الشعوب الإسلامية ومقدراتها . ورغم المقاومة المشرفة مغربا ومشرقا للاستعمار إلا أن حركات التحرر الوطني والتي اتخذت من الإسلام شعارا ووسيلة – في أغلبها – فشلت في أمرين الأول: لم توجد تنسيقا مشتركا يخطط في المستقبل لوحدة البلاد العربية والإسلامية رغم وجود التنسيق الحربي بين هذه الحركات، والثاني: لم تفلح بعد طرد الاستعمار في تولي مقاليد الحكم .فقد نجح المستعمرون الأوربيون في أن يضمنوا لحلفائهم ولمن تمت صناعاتهم في الجامعات والكليات الحربية في الغرب أن يتولوا قيادة دولهم الحديثة ،وهذه المرحلة شهدت سيادة كثير من الحكام ممن لا علم لهم ولا سياسة في الغالب الأعم، وهو ما جعل كثيرا من الدول الإسلامية إلى اليوم تعيش استقلالا صوريا أكثر منه فعليا ،فالكثير من النخب ومن القوى في بلداننا اليوم بشكل واع أو غير واع تحافظ على مصالح تلك القوى وأحيانا على حساب المصالح والسيادة الوطنية فضعف النخب الحاكمة وتراجع شرعيتها ،وعدم كفاءتها السياسية والمعرفية ،وارتباطها العضوي بالمصالح الخارجية للدول المستعمرة تاريخيا،هو ما أدى إلى فشل ما يعرف بدولة الإستقلال ،وفشل نخبنا الوطنية الحاكمة في التصدي بنجاح للأعباء والاستحقاقات ، وخصوصا تحديات التوحد والتقدم …،وهو ما يجعل الباحث المنصف في تاريخ السلطة العربية و الإسلامية يحكم بأن أغلب الذين قادوا دولنا الوطنية إما بالعسكرتاريا أو بالتغلب والدعم الأجنبي، لم يبلغوا شأو حكم العلماء تاريخيا بل وتقاصروا عن حكم جهال بني أمية والعباس وعثمان …!فما هو يا ترى الأساس العلمي والتاريخي الذي يمكن أن يسند دعوى أن العلماء بمعنى (الفقهاء) لا يصلحون للسياسية (بمعنى الحكم) ؟!
في المنظور الإسلامي نعتقد كمسلمين أن العلماء حملة علم وفكر ونور،وأنهم ورثة الأنبياء وإرث الأنبياء هو إرث العلم والعمل به وإرث مهماتهم (ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالعدل…). أليست مفردات “الخلافة “و”الحكم” و”الناس” و”العدل” هي زبدة المفاهيم السياسية.؟ أليس الإيمان مقرونا في القرآن بالحكم والتحكيم وقبول الأحكام بل والاطمئنان بها ؟( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..).أليس من المغالطات أن نذيع أن العلماء لا يصلحون للسياسة ؟ألا ينطوي ذلك ضمنا على كون حملة الوحي وكلام النبوة وسير الأنبياء والمصلحين لا يصلحون لقيادة الناس “للخير العام” إنها قولة تشي بمفهوم المخالفة أن من لا يفقهون الدين ولا يعرفون الشرع هم من يصلح للسياسة . إن علماء السياسة الشرعية قديما اشترطوا للولاية أو الإمامة (الرئاسة) عشرة شروط أساسية تلخصها كفاءات ثلاثة :أجملها البعض في الكفاءة الروحية والعلمية والعملية في من يتصدى للقيادة .ومعناه أن من حصلت له الكفاءات الثلاث هو صالح لتولي قيادة الدولة ، وعليه فليس كل الناس ولا كل العلماء يصلحون للحكم والسياسة بالطبع، كما أن شبهة تحول حكم الفقيه (العالم) إلى سلطة ثيوقراطية غير واردة ،فالعالم لا يحكم الدولة إلا بصفته حاكما زمنيا يجتهد في تطبيق الشرع وليس ظل الله في الأرض “ولا يحزنون”. فهو إنما يؤسس لتجربة إنسانية تتخذ من فهم الشريعة مرجعية وذلك هو الأصل في تجربة الدولة الإسلامية ، وبالتالي في اعتقادي الخاص أن العالم إذا فقه النور الذي جاء به النبي (ص) وفقه سنته وسيرته ،وتعلم علوم التاريخ والسير ورفد ذلك بحسن التدبر والنظر وأتبعه بالخبرة والمخالطة، وتكونت لديه ملكة سياسية ،فلعمري هو الجدير بحكم الناس .
إن من يطلقون هذه المقولة القلقة ويعتنقونها هم في الغالب لا يدركون معنى العالم ولا يدركون معنى الفقه الحقيقي أو يختزلونه في مساحة ضيقة هي معرفة الحلال والحرام في أحكام العبادات …فينزلون بمفهوم العالم – الذي هو شخص على سوية عالية من الإدراك والتبحر بالنص والواقع وجدلية التفاعل بينهما – من مستوى القدوة والرعاية والقيادة للأمة إلى مستوى فقيه القرية. ونشك حتى في فهمهم للمعاني المحايدة والتقنية والفنية لكلمة سياسة.
فإطلاق الحكم بعدم صلاحية الفقهاء للسياسة وبدون ضوابط يتجاهل أمرا رئيسا في الدين الإسلامي وفي فقهه وشريعته ومنظومته الفكرية والمفاهيمية ،وهو أنه ما نزل إلا ليعمل به فهو من الحق وبالحق نزل ويهدي للحق ومنزه عن العبث .وعلى مستوى الفلسفة التشريعية وكذا الأحكام هناك من الأوامر والتوجيهات ما يحتاج لنفاذه إلى قيام السلطة (بمعنى الحكم) فالسلطة أو الحكم أو السياسة من صلب أمر الدين .،فعلى مستوى المفاهيم الأساسية فالسياسة والدنيا ليستا شيئا زائدا على الدين ،فإذا كان الأمر هكذا في الإسلام ، وإذا كانت السياسية في أحد تجلياتها هي التعاطي مع الشأن العام عن طريق الانخراط والمشاركة ، وإذا كانت المعرفة بجميع جوانبها ضرورية لممارسة السياسة .،فالفهم الإسلامي يجعل من العالم إنسانا ومواطنا يمشي في الأسواق ،وهو مؤهل ومخاطب بوضع الأحكام الشرعية (كجمل نظرية ) في إطار الفعل والممارسة أي قيادة التغيير والإصلاح داخل مجتمعه ودولته، سواء كان العالم في موقع قيادة سياسية ويقود تجربة في الحكم ،أو كان دوره مقتصرا على قيادة ميادين أخرى كالإفتاء والإرشاد ، إن الإسلام كنصوص لا يجعل “فيتو” و لا يحجر على فرد أو جماعة محددة في دخول معترك الشأن العام ويظل الأمر بالنسبة له متعلقا بالاستعددات الخاصة بكل شخص. كما لا يفوتنا التأكيد أن وراء هذا الإطلاق وهذا الموقف عقلية إقصائية لدى أغلب الفاعلين في الحقل السياسي .،- إذا فشلوا في استخدام الدين لخدمة أهدافهم – فكثيرا ما نلحظ السياسيين في العالم العربي يتأففون من تدخل رجال الدين (العلماء) في السياسة بدعوى الحفاظ على الدين وعدم النزول به إلى مستوى تفاصيل الصراع اليومي – وأنا لا علم لي بفكر يستعد للإنسان قبل المولد ليرافقه في الحياة وبعدها مثل الدين – وهو موقف عام لدى السلطة من العلماء ومن المثقفين ، وهو توجه خطير من نتائجه أنه يرمي باتجاه فصل الشأن العام عن كل ماهو ثقافي .، وبالتالي فصل القرار الرسمي عن أن يكون محاطا بالعلم ،كما أنه يشي بتلك الإرادة لدى الحكومات في العالم العربي والإسلامي لتأبيد أنظمتها والاستئثار بالسلطة والوقوف في وجه التغيير الذي يتخذ من العلم والعقلانية والتنوير منطلقا وهدفا له ،وهو ما يجعل مثقفي التبرير ينشرون ويرددون تلك المقولات الساذجة بعدم صلاحية العلماء للسياسة ،وأن ليس بالإمكان أبدع مما كان.
ويكون مفاجئا ومدعاة للتأمل والدراسة حين تخترق تلك التصورات والمواقف النخب المثقفة “الانتلجسيا” والتي يفترض أن تبني مواقفها لتنسجم مع نمط من التفكير العلمي والعقلاني الرفيع .ومن بين تلك المقولات الشائعة تلك المتعلقة بإشكال لدى بعض النخبة يظهر في كتاباتها ومواقفها من حين لآخر،ويلخصه التساؤل عن مدى صلاحية الفقيه (العالم) للسياسة (السلطة ،بمعنى الحكم بشكل أدق)؟! بل وينزل أحيانا إلى الشكوى من الفقهاء ليأخذ عليهم إبداء الرأي في الأمور السياسية. و سنحاول من خلال هذه المحاولة تفكيك هذا التساؤل أي ما مدى قبول مشاركة العلماء الفقهاء في السياسة (ممارسة أو تنظيرا) هذا التساؤل الذي يستبطن حكما وموقفا من نوع معين في ذهنية هؤلاء.، وللوقوف على صلاحية و جدارة هذه المقولة ومحاكمتها إمبريقيا ومنطقيا ومعرفة ما وراءها لا بد من تفريعات تساؤلية لهذا الإشكال من نوع : من هو الفقيه؟ وماهو الفقه؟ ومن هو السياسي؟ وما هي السياسة؟ أليس من المشروع استنطاق تجربتنا السياسية التاريخية؟ هل عرفنا فقهاء حاكمين ؟ وما مدى رشدية الحكم في زمن خلفاء الفقه وسلاطين السياسة؟ وهل قيادة الفقهاء لمؤسسة السلطة داخل المجتمع يحولها من “سلطة زمنية” إلى “دينية” بالضرورة؟ وهل يكفي إطلاق حكم بأن الفقهاء لا يصلحون للسياسة لمجرد فشل بعض التجارب السياسية للعلماء، أو القول به من أحد العلماء المعتبرين والمشهورين في التاريخ للأخذ بهذا الرأي؟ علام تنطوي هذه المقولة؟ هل هي مقولة ساذجة عفوا؟ أم مقولة حبلى بالنوايا والأهداف الخفية؟
_ في حياتنا الفكرية والثقافية و حتى السياسية اليوم مقولات سائدة تؤلف جزءا هاما من وعينا إلى حد بعيد وبشكل غير مدرك غالبا ولا منظور، برغم البساطة والسذاجة التي قد تطبع هذه المقولات وتجعلها زائفة عندما نخضعها للفحص والمحاكمة العقلانية والعلمية الدقيقة ،سواء من النواحي النظرية أو العملية .وهذه القولات اللاعلمية في جوهرها ، عصية على الحصر والتعداد في مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة والتي رغم شيوع المعرفة والتطور العلمي،إلا أنها لا تزال تقوم في ذهنيتها مجموعة من الأحكام والتصورات ذات الطبيعة الإقصائية والتبسيطية والاختزالية .،وهو ما قد يكون مقبولا أو معتادا في الطبقات ذات الوعي المتدني والمستوي العلمي الضعيف.